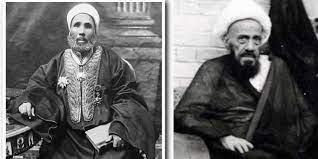المقالات

القسم الولائي
الإمام الحسين عليه السلام في تراث الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله
تمهيد:
إن من أعظم النهضات التي شهدها التاريخ العالمي هي نهضة الإمام الحسين الإصلاحية، إن لم نقل: أعظمها على الإطلاق، فضلاً عن عظمتها في الواقع الإسلامي؛ لذلك نجد أن هذه الحركة المباركة قد أخذت حيّزاً واسعاً من البحث والتنقيب والتحليل في كتابات العلماء والمحققين والفضلاء، سيما قائدها الشهيد الحسين بن علي عليهما السلام .
من هنا؛ سوف نُسلط الضوء على تراث أحد العلماء الكبار وبالمقدار الذي يختصّ بنهضة الإمام الحسين عليه السلام ، ألا وهو تراث الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وفي البدء لا بد من إطلالة تعريفية بهذا العالم الجليل، فنقول:
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ولِدَ الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي، بن محمد رضا، بن موسى، بن الشيخ جعفر الكبير، بن الشيخ خضر، بن يحيى، بن سيف الدين في النجف الأشرف عام 1294هـ/ 1877م[1].
وينتسب الشيخ محمد إلى عائلة عربية يمنية، هاجر جدها الأعلى ـ الشيخ خضر بن يحيى ـ إلى النجف الأشرف منذ ثلاثمائة سنة تقريباً من جناجة[2] جنوب الحلة[3]. وقد أُطلق على أُسرته اسم كاشف الغطاء نسبة إلى كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرَّاء، وهو كتاب في الفقه والأحكام، ألّفه أحد علماء أُسرته وهو الشيخ جعفر بن الشيخ خضر1149هـ/ 1736م ـ 1223هـ/ 1808م، صدر سنة 1205هـ/ 1790م[4].
توفرت للشيخ محمد بيئتان علميتان: بيئة علمية خاصة، والتي تمثلت بأُسرته التي كانت ذات توجّه علمي ديني[5]، ولا سيما والده الشيخ علي الذي تولّى تربيته وتعليمه[6]. وبيئة علمية عامة، تمثلت بالوسط الحوزوي في مدينة النجف الأشرف، الذي كان الشغف بالعلوم أبرز ميزاته؛ لا سيما وقد شهدت النجف في فترة نبوغ الشيخ حركة علمية وفكرية، وثقافية وأدبية واسعة النطاق، ووصلت إليها الكثير من الأفكار الحديثة التي تأثرت بها الطبقة المثقفة في المدينة، وساعدت المجلات الصادرة في مصر وسوريا وبعض البلدان الإسلامية في نشر ثقافة جديدة مهّدت لنهضة فكرية في هذه المدينة المقدسة[7]، ولعل الأمر الأهم الذي جعل هذه الظروف المساعدة عامل بناء حقيقي في شخصية الشيخ هو نشاطه وهمَّته في تلقِّي العلم، والتعلُّق بأهل الفضل، والاستزادة من الحكمة والخير؛ وقد وصف لنا هذا العامل الذاتي بيراعه البليغ، فقال: «إني منذ عرفت ليلي ونهاري، وميزت بين خشونة رأسي ونعومة أظفاري لم أصبُ ولم أتعلّق إلّا بمدارسة الكتب ومزاولة العلم والتعلم، واللصوق بأهل الفضل والفضائل، والمثول بين يدي الأكابر والأماثل، اقتباساً من فوائدهم، وتطفلاً على موائدهم»[8].
شخصيته العلمية
من الطبيعي أن تنعكس هذه المؤثرات على شخصية الشيخ وتُساهم في إعداده، حيث انفتح منذ نعومة أظفاره على الثقافة المعاصرة ـ فضلاً عن الثقافة الحوزوية[9] ـ وانعكس ذلك على نشاطه المبكر في حقل اللغة والأدب، والسياسة والقانون فيما ألّف، وناقش كبار المفكرين المعاصرين في مختلف فروع المعرفة، بفضل الصحافة والمؤتمرات والمقابلات، واضطلع بمهمات ثقافية وإسلامية... بما يخدم الحقيقة والإسلام، ليس هذا فحسب، بل نشط في ميدان التحرك الاجتماعي والسياسي[10].
فكان بالإضافة إلى الواجبات الدينية والعلمية مثل صلاة الجماعة والخطبة والوعظ والتدريس والتأليف والإفتاء، يندمج في حياة الناس، ويشفع لدى المسؤولين في قضاء حوائجهم، أو المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية[11]. وكان له دور مُشرّف في الأحداث الوطنية، جسدت تفاعله مع الساحة العراقية، وسعيه الحثيث لتحرير العراق، وزيادة وعي أبنائه[12]، ناهيك عن مواقفه الشجاعة في دعم القضية الفلسطينية التي أخذت من نشاطه وهمته الكثير[13].
وقد انسجم هذا التوجه المتنوع والمتنور مع ما كان يؤمن به من أن «وظيفة العالم لا تنحصر في الفتوى فقط، بل أهم وظائفه الإرشاد والإصلاح... والعلماء ورثة الأنبياء والأوصياء؛ فيجب أن يقتدوا بهم في التزكية والتهذيب»[14].
وكان هذا العالم العامل يقول: إذا كان الوعظ والإرشاد والنهي عن الفساد، والنصيحة للحاكمين بل لعامة العباد، والتحذير من الوقوع في حبائل الاستعمار والاستعباد، ووضع القيود والأغلال عن البلاد وأبناء، البلاد، من السياسة فأنا غارق فيها إلى هامتي وهي من واجباتي، وأراني مسؤولاً عنها أمام الله والوجدان؛ فإن الله قد أخذ على العلماء ألّا يقاروا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم[15].
كاشف الغطاء والتقريب
قد انطلق الشيخ كاشف الغطاء للتقريب بين المسلمين بجميع مذاهبهم، ودعا المسلمين للتخلّي عمّا يُثير الآخر، والتوقُّف عن إثارة المسائل الخلافية التي تزيد الفرقة، وتقوي الشقاق بين أبناء الدين الواحد[16].
وكانت جهود الشيخ في هذا المضمار تلقى ترحيباً ودعماً شعبياً واسعاً؛ فعندما ذهب الشيخ كاشف الغطاء إلى القدس؛ لحضور المؤتمر الإسلامي العام سنة1350هـ ـ1931م اجتمع عدد غفير من أهالي فلسطين في المسجد الأقصى، يبلغ عددهم نحو عشرة آلاف نسمة، ومعهم أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 150 عضواً من أعيان العالم الإسلامي، فطلب مُفتي فلسطين السيد أمين الحسيني من الشيخ كاشف الغطاء أن يتقدم إماماً لصلاة العشاء؛ فأجاب طلبه وخطب بعد الصلاة خطبة طويلة، عُرِفت بالخطبة التاريخية، وكانت صلاة الجماعة هذه بذرة للتقارب والأُلفة بين المذاهب الإسلامية[17]، وقد نشرت الصحف العالمية هذا الحدث، وعندما رجع الشيخ من سفره استقبله الناس بحفاوة بالغةٍ، ونظمت القصائد بحقه، وقد أُحصي ما قيل فيه؛ فوجد أنه يزيد على العشرة آلاف بيت، وهو الآن موجود في مكتبته[18].
كاشف الغطاء وموقفه من الصهيوأمريكية
من المواقف الصلبة للشيخ هو رفضه الدعوة التي وجهتها إليه جمعية أصدقاء الشرق الأمريكية؛ لحضور مؤتمر في بحمدون ـ لبنان لمناقشة القيم الروحية في الدين الإسلامي والمسيحي وتأثيرات الأفكار الشيوعية، وبعد رفض حضور المؤتمر[19]، ألّف كتابه المُثل العليا في الإسلام لا في بحمدون؛ كوثيقة ضد المؤتمر، وداعياً فيها إلى مقاطعته، وقد عدَّ الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية هي الخطر الأكبر الذي يُهدد العرب والمسلمين والإنسانية[20].
وقد عد الناس الشيخ كاشف الغطاء رجلاً شجاعاً معبِّراً عن شعورهم وآلامهم، وممثلاً عن آرائهم ومصالحهم، وقد نوّهتْ بالكتاب عدد من الصحف العراقية واللبنانية بما يستحقه من الإطراء[21]، ووردت إلى سماحته رسائل كثيرة، وبرقيات يُبدي أصحابها سرورهم لصدور الكتاب واستحسانهم موقفه المشرف من المستعمرين، وإعجابهم ببلاغته وأصالة آرائه التي أبداها بصراحة ووضوح[22].
كاشف الغطاء والعطاء العلمي
ترك الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء تراثاً كبيراً أغنى المكتبة العربية والإسلامية، وقد تنوعت مصنفاته، وجال فكره الثاقب في شتّى ميادين العلوم؛ فترك ما يربو على الثمانين مؤلّفاً[23]، في مجال التاريخ، والفقه، والسياسة، والدين، والأخلاق، فضلاً عن المؤلفات ذات الطابع الإصلاحي العام[24].
كانت مؤلفات الشيخ على قسمين: فمنها ما كان ينصرف فيه للتحضير والإعداد والمراجعة، ومن ذلك: مؤلفاته الفقهية، والأُصولية، والكلامية، والأدبية، مثل شرح العروة الوثقى فقه استدلالي، وتقريرات وبحوث في الأُصول والدين والإسلام وغيرها كثير؛ وهناك قسم آخر من تآليفه، يؤلف على أساس حاجةٍ ماسة، أو نتيجة طلب وإلحاح من ذوي الفكر والمثقفين، أو ردّ بعض الأقلام التي تطغى عليها النزعة المذهبية؛ فتحفزه وتضطره إلى التأليف ودفع الشبهات، ورد الطعون[25]، ومن ذلك: كتاب أصل الشيعة وأُصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة الذي جاء ردَّاً على الأقلام التي أخذت تطعن بالإمامية عن جهل، وقد وصف الشيخ هذا الدافع بقوله: «ولم تبرح أقلام الأساتذة المصريين في كل مناسبة تطعن بالشيعة، وتنسب إليهم الأضاليل والأباطيل التي كانت تُنسب إليهم في العصور المظلمة والقرون الوسطى»[26].
فقد ذكر أحمد أمين أن التشيع كان مأوًى يلجأ إليه كل مَن أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومَن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية وهندية[27]، وقد اتخذ باحثون آخرون ذلك منطلقاً للإساءة إلى معتقدات الشيعة جميعاً.
وقد أقام الشيخ كاشف الغطاء الدليل في هذا الكتاب على صحة معتقدات الشيعة، ودفع الشبهات عن أُصول عقائدهم مع «اللباقة في التصرف، ومع التألق في الدفع بالتي هي أحسن، ومع التلطف في عدم إثارة الحفائظ»[28].
الإمام الحسين عليه السلام في تراث الشيخ كاشف الغطاء
كان للإمام الحسين عليه السلام حيز واسع في تراث الشيخ كاشف الغطاء، وإن ظل ما كتبه عن هذه الشخصية الفذة دون طموحه؛ إذ حالت دونه حوادث الأيام، وتقلبات الصروف[29].
وسنعرض فيما يأتي أبرز المؤلفات التي وصلت من تراث الشيخ كاشف الغطاء بخصوص الإمام الحسين عليه السلام :
1ـ الأرض والتربة الحسينية
وهو كتيّب صغير أو كما سُمِّي بـالرسالة، يتألف من64 صفحة من القطع الصغير؛ وقد ألَّفه الشيخ بعد أن عرضت عليه رغبة أحد المستشرقين بالحصول على تاريخ حقيقي شامل لجميع نواحي التربة الحسينية؛ لإدراجه في دائرة المعارف الإنجليزية[30]، فلم يتوان جهده في اغتنام الفرص والعمل الجادّ حيال الواجب الديني، وقد توسّع فيه إلى البحث عن مطلق الأرض وخيراتها وأركانها وقدسيتها، بنحو ديني أدبي تاريخي، ثم تعرّض إلى التربة الحسينية.
ومن بديع استنباطاته حول بركة الأرض ـ بعد أن أورد الأحاديث النبوية الشريفة التي تُشير إلى تكريم الأرض ـ قوله: «أفلا يتبيَّن من هذا سرّ أمر الباري جل شأنه للملائكة جميعاً أن يسجدوا لآدم الذي خلقه من تراب وأنشأه من الأرض، وأودع فيه جميع خواصها وعناصرها.. فليسجدوا لآدم عبادةً لله؛ وتقديساً وتكريماً للأرض ذات الخيرات والبركات، والمحيا والممات»[31].
ومن ذلك تدرّج إلى الاستنتاج بأن هذا هو سرُّ امتناع إبليس المخلوق من النار عن السجود لآدم المخلوق من الأرض، والعداء والنفرة بين النار والأرض فـ«الأرض مُجمعة والنار مفرقة؛ والجمع قوة والفرقة ضعف، الأرض باردة معتدلة والنار محرقة مشتعلة، الأرض نمو وزيادة والنار إفناء وإبادة، الأرض يعيش بها كل حيٍّ والنار يهلك بها كل حيٍّ، إذاً؛ فليسجد الملائكة لآدم، وليسجد أبناؤه لله على الأرض؛ فإنها أُمهم البرّة الحنون»[32].
وقد أشار الشيخ إلى أن الأرض مع وحدتها وتساوي بقاعها وأجزائها ظاهراً، إلّا أنها في الحقيقة مختلفة في البقاع والطباع والأوضاع؛ ففيها الطيبة والخبيثة، والحلوة والمالحة، والسبخة والمرَّة، ولا شك في أن الطيب النافع هو الحري بالكرامة والتقديس، ولا يبعد أن تكون تربة العراق على الإجمال من أطيب بقاع الأرض في دماثه طينتها وسعة سهولها، وكثرة أشجارها ونخيلها، وجريان الرافدين عليها، ثم لو تحرَّينا هذه السهول العراقية وجدنا من القريب إلى السداد القول: إن أسمى تلك البقاع، أنقاها تربةً، وأطيبها طينةً، وأذكاها نفحة هي تربة كربلاء الحمراء الزكية؛ فكان من صميم الحق أن تكون أطيب بقعة في الأرض مرقداً وضريحاً لأكرم شخصية في الدهر، وبهذا ينضمُّ إلى شرف تربة كربلاء الجوهري «باعتبارها أكرم مادة، وأطهر عنصراً، وأصفى جوهراً، من سائر البقاع» ينضم إليها طيبها العنصري[33].
وقد ناقش الشيخ كاشف الغطاء قضية السجود على الأرض ـ إذ لا يجيز الفقهاء السجود إلّا على الأرض أو ما ينبت منها، غير المأكول والملبوس ـ وأفضلية السجود على التربة الحسينية، وحاول أن يجد بعض ما لم يسبق إليه في هذا المجال؛ فأضاف إلى ما ورد من فضلها في الأخبار، وأنها أسلم من حيث النظافة والنزاهة من السجود على سائر الأراضي، فقال: «لعل من جملة الأغراض العالية والمقاصد السامية، أن يتذكر المُصلّي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام بنفسه وآل بيته والصفوة من أصحابه، في سبيل العقيدة والمبدأ، وتحطم هياكل الجور والفساد والظلم والاستبداد؛ ولما كان السجود أعظم أركان الصلاة ـ وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ـ مناسب أن يتذكّر بوضع جبهته على تلك التربة الزاكية أُولئك الذين وضعوا أجسامهم عليها ضحايا للحق، وارتفعت أرواحهم إلى الملأ الأعلى؛ ليخشع ويخضع، ويتلازم الوضع والرفع، ويحتقر هذه الدنيا الزائفة وزخارفها الزائلة»[34].
وقد تطرّق الشيخ ـ بعد أن عدّ مزايا الأرض والتربة الحسينية ـ إلى ما ورد في الكثير من الأخبار والآثار، في أن الشفاء قد يحصل من تربة الحسين عليه السلام ؛ ويتساءل: «أفلا يجوز أن تكون في تلك الطينة عناصر كيمياوية تكون بلْسماً شافياً من جملة الأسقام، قاتلةً للميكروبات؟»[35].
ثم مزج هذا التساؤل برجاء ـ لا يزال يتوانى عن تحقيقه باحثونا ودارسونا إلى اليوم ـ فقال: «ولعل البحث والتحرّي والمثابرة سوف يوصل إليها، ويكشف سرَّها، ويحل طلسمها، كما اكتُشِف سرُّ كثير من العناصر ذات الأثر العظيم، مما لم تصل إليه معارف الأقدمين»[36].
وقد تضمن هذا الاحتمال طعناً على كل مَن يُبادر إلى إنكار أهمية تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء دون أن يُقيم برهاناً على إنكاره.
ومما لم يغفله الشيخ كاشف الغطاء في رسالة الأرض والتربة الحسينية، الرد على قول «بعض مَن يحمل أسوأ البغض للشيعة: إن هذه التربة التي يسجدون عليها صنم يسجدون له. هذا مع أن الشيعة لا يزالون يهتفون ويُعلنون في ألسنتهم ومؤلفاتهم أن السجود لا يجوز إلّا لله تعالى، وأن السجود على التربة سجود له عليها، لا سجود لها»[37].
ويمكن القول: إن الشيخ كاشف الغطاء قد قدّم عرضاً حسناً لهذا الموضوع، مع ما فيه من الجدة والطرافة، وحَرَصَ على ذِكْرِ نواحٍ أُخرى تتعلَّق بالأرض تشريعية أو تكوينية، مع عدم إغفاله للنقد لبعض ما ورد عن خلق الأرض وفي كتب الشيعة أنفسهم، مما قد يكون أقرب إلى الخرافة منه إلى الحقيقة النافعة[38]؛ مما يعكس جديةً في البحث، وموضوعيةً في الرأي، ورغبةً في تحقق النفع واستقصاء الحق.
2ـ مقتل الحسين عليه السلام
ويبدأ من ليلة العاشر من محرم الحرام، ويسرد وقائع تلك الليلة باختصار؛ إذ يبدو أنه يختصر هذا الكتاب المطبوع الذي يصل فيه إلى حين مقتل الحسين عليه السلام من كتاب أوسع؛ فقد ذكر في الصفحة الأُولى قائلاً: «اختصرناه من مقتل لنا صغير أوسع مما كتبناه هنا»[39].
ولم يُعثر على ذلك المقتل الواسع في تراث الشيخ كما يذكر ذلك نجلُه[40]، ويبدو للباحث أن ذلك المقتل المفقود ما هو إلّا المجالس الحسينية التي بدأ بتحقيقها أحمد بن علي بن مجيد الحلي في شهر رجب سنة 1428هـ/ 2007م، والتي تسنّى للباحث أن يطّلع عليها، وبعد دراستها ومقارنتها بكتاب مقتل الحسين وجدنا أن كتاب المقتل المطبوع هو جزء من المجالس الحسينية، ويبدأ من المجلس الثالث بالتحديد، والذي يذكر وقائع ليلة عاشوراء[41]، فضلاً عن أن المقتل ـ الذي صرح الشيخ أنه صغير أصلاً ـ لا يمكن أن يكون أوسع من ذلك إلّا إذا أُضيفت إليه تفاصيل الوصول إلى كربلاء، كما في المجالس الحسينية.
ومما يؤكد هذا الاستنتاج؛ أن الشيخ كاشف الغطاء كان يرتّب واقعة الطف على عشرة مجالس مختصرة؛ لتُقرأ في كل يوم من أيام العشرة الأُولى من محرم الحرام، في مشهد حافل بالناس، في الدار الكبيرة حسب العادة في ذلك الحين، وفي اليوم العاشر يقرأ هو بنفسه واقعة الطف ومصرع سيد الشهداء عليه السلام [42].
وهذا الأمر يوافق ترتيب المجالس الحسينية التي تبدأ من ذكر أهمية البكاء على الحسين عليه السلام ، ثم تفاصيل خروجه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، مفصّلاً في سياسة عبيد الله بن زياد في الكوفة واستشهاد مسلم بن عقيل، وهانئ بن عروة، وهي تفاصيل تستوعب حوالي تسعة أيام أو أكثر، إذا أراد الخطيب ذلك، ثم ذكر تفاصيل ليلة عاشوراء، وهي في المجالس الحسينية كما في كتاب مقتل الحسين عليه السلام نصاً، ودون إضافات أو اختلاف، وأبرز كرامات الحسين عليه السلام أثناء المعركة، وقد ركَّز على خطب الحسين عليه السلام في المعسكر المعادي، وخطب أصحابه ومقاتلهم وأهل بيته عليهم السلام ، ثم استشهاد الحسين عليه السلام ، وختم المقتل بفجيعة السيدة زينب عليها السلام بأخيها، وخروجها نادبةً له[43]، وقد كان المقتل في كلا الكتابين عبارة عن سرد تاريخي خالٍ من التعليقات إلّا ما ندر، ومن ذلك تعليقه على خطب الحسين عليه السلام في المعسكر المعادي بالقول: «وكانت تلك الخطب المتقدمة قبل الشروع في الحرب، لا للإعذار والإنذار وإتمام الحجة فقط، ولا تفادياً من الحرب، وخوفاً من الموت، وركوناً إلى حب الحياة ـ معاذ الله ـ ولكنه سلام الله عليه بما أنه باب الوسيلة، ومفتاح خزائن الرحمة، وينبوع مجاري النجاة، لا جَرَمَ أن غرائز الحنان والرحمة كانت تدفعه إلى مدافعة ذلك الخلق المتعوس عما حاولوه، وصمموا عليه من قتله، الذي فيه هلاكهم المؤبد»[44].
لقد كانت تلك المدافعة عبر المواعظ والحجج التي ساقها الحسين عليه السلام ، بغية توعية الجيش الزاحف لحربه، لعلها تترك أثرها فيهم.
لقد اعتصم الإمام بالمنطق في التحاجج؛ مطالباً أهل الكوفة من الذين شحذوا سيوفهم لقتله وقتل أصحابه، بأن يستخدموا ما أعطاهم الله من عقل وفكر، وأن لا ينساقوا كالهمج الرعاع، وبذلك وضع الإمام يده على الجرح عندما أراد أن يُحرّرهم من استبداد الطغاة والدعاية المضللة والفكرة الخاطئة، وأن يمنحهم قوة الشخصية؛ لكي يفكروا ويتساءلوا ويبحثوا عن الحقيقة بأنفسهم، ولم ينسَ أن يستخدم أُسلوب العتاب وتأنيب الضمير علاجاً لكثير من الحالات الانهزامية والشلل النفسي والازدواجية[45].
وقد رجع الشيخ في كتابيه المجالس الحسينية، ومقتل الحسين، إلى عدة مصادر كان يذكرها أحياناً في متن الحديث مثل[46]:
* التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام .
* آمالي الشيخ الصدوقت 381هـ/930م.
* مروج الذهب، للمسعوديت346هـ/ 957.
* الإرشاد، للشيخ المفيدت413هـ/ 1022م.
* الكامل في التاريخ، لابن الأثيرت360هـ ـ 1232م.
* اللهوف، لابن طاووست664هـ/ 1265م.
وغير ذلك من المصادر، وكان يُعرض أحياناً عن ذكر المصدر مكتفياً بالقول: «قال أرباب المقاتل»[47]، أو «روى جميع أرباب المقاتل وأثبات المؤرخين الأفاضل»[48]. وهو بذلك يفرز بعض الروايات التي عليها إجماع المؤرخين ومؤلفي كتب المقاتل.
ومما تنبَّه إليه محقق المجالس الحسينية: أن الشيخ كاشف الغطاء يختم روايته لمقتل الحسين عليه السلام بالقول: «ونادى شمر لعنه الله: ويلكم ما تنتظرون بالرجل؟ فلم يجسر عليه أحد، فنزل هو إليه بنفسه. وكان ما كان من إنفاذ مسطور، ولا حول ولا قوة إلّا بالله»[49].
فقال المحقق معلقاً على ذلك: «وانقطع قلم المؤلف رحمه الله ؛ لعظم الخطب الجسيم، ولبشاعة ما جرى على إمامنا الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه من مصائب جسام.. فلذا أودُّ أن أُذكّر إخوتي من خطباء المنبر الحسيني، بأن يقتصروا على ذكر مصرع سيد الشهداء عليه السلام في يوم عاشوراء فقط، وينتهجوا نهج المؤلف رحمه الله ؛ وذلك لئلا يهون الخطب وتتعوَّد عليه مسامع بني البشر»[50].
ولعل المحقق أدرك ذلك لما عرف عن الشيخ كاشف الغطاء من اهتمام بإصلاح المنبر الحسيني؛ لأنه الآلية التي أخذت موقع الصدارة في ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام ، ومسؤولية الخطيب تقتضي التعريف بمفاهيم الإسلام، وطرح الفكر الإسلامي الواعي؛ لغرض توعية الأُمة الإسلامية فكرياً وسياسياً، وتوطيد أواصر الوحدة الثقافية بين المسلمين.
ولهذا؛ ينبغي أن تتوفر مواصفات مهمة في شخصية الخطيب، منها: الوعي الناضج في توجيه الجماهير، وامتلاك عُدَّة كافية من الفكر والثقافة والتاريخ؛ لأن المنبر أضحى في المجالس الحسينية المركز الرئيسي الذي تلتفُّ حوله الجماهير الشعبية، وتستمع بإذعان إلى ما يقوله الخطيب، الذي يناقش قضايا وأفكاراً تمسّ الواقع الإسلامي؛ لذا أضحى المنبر ذا قيمة جماهيرية، وقاعدة شعبية، وله صوته الثقافي والفكري المؤثر في الوسط الاجتماعي، وتوعية الأُمة سياسياً وفكرياً[51].
وبهذا أخذ الشيخ كاشف الغطاء يوجّه كلماته الإصلاحية الواعية إلى الخطباء، في استغلال هذه القاعدة الجماهيرية وتوجيهها نحو الإسلام الفعلي الواعي[52]، من دون الاكتفاء بذكر ثواب البكاء فقط، أو التركيز عليه وترك الإلحاح على المبادئ الأساسية التي استُشهد من أجلها الإمام الحسين عليه السلام ، فيقول: «إن اللازم على خطباء المنابر والذاكرين لرزية الحسين عليه السلام في هذا العصر الذي ضعفت فيه علاقة الناس بالدين وتجرّأ الناس على المعاصي، وتجاهروا بالكبائر أن يفهموا أن الحسين قُتل وبذل نفسه لأجل العمل بشعائر الدين، فمن لا يلتزم بأحكام الإسلام ويتجاهر بالمعاصي فالحسين عليه السلام منه بريء، كبرائته من يزيد وأصحاب يزيد، وأما ذكر أخبار الثواب فقط ففيها أعظم الإغراء»[53].
وقد قوّم الشيخ بعض مراسيم العزاء التي تُقام إحياءً لذكرى الحسين عليه السلام ، ووجد أنها مظهرية أكثر مما هي جوهرية، فارتقى منبر الوعظ وخطب في الناس قائلاً: «سيد الشهداء علَّم كل الدنيا ـ لا خصوص الشيعة ـ طريقة الإباء والعز، والشرف والشهامة، فعل فعلاً فريداً من نوعه؛ ليُعلِّم شيعته الإباء والتمسك بالمبادئ المقدسة، ولكنا تركنا اللباب وأخذنا القشور، واقتصرنا على النوح واللطم والبكاء. أنا لا أقول: لا تلطموا. بل أقول: لا تقتصروا على القشور والظواهر، وتتركوا اللباب والجواهر»[54].
وقد كان الشيخ يرى أن ذلك جناية عظمى على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام [55].
وفي هذا المجال نفسه كانت تُوجَّه إليه رحمه الله بعض التساؤلات، لا سيما في شهر محرم الحرام ـ الذي يقوم فيه الشيعة بمراسيم العزاء ولطم الصدور حزناً على سيد الشهداء ـ وكانت بعض هذه الأسئلة تدور حول جواز هذه المراسيم أو عدم جوازها. وقد كان الشيخ جريئاً شجاعاً[56]، وهو يتعرض لهذه الظاهرة الشعبية المتأصلة نوعاً ما في الوسط الاجتماعي الشيعي، فذكر ما نصه: «مسألة لطم الصدور ـ ونحو ذلك من الكيفيات المتداولة في هذه الأزمنة، كالضرب بالسلاسل والسيوف وأمثال ذلك ـ إن أردنا أن نتكلم فيها على حسب ما تقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية؛ فلا تساعدنا إلّا على الحرمة، ولا يمكننا إلّا الفتوى بالمنع والتحريم»[57]، ولكنه استدرك مميِّزاً بين ما يجري من تلك الأعمال إخلاصاً لقضية الحسين عليه السلام ، وبين ما يقع منها على نحو المراءاة، فقال: «ولكن هذه الأعمال والأفعال إن صدرت من المكلف بطريق العشق الحسيني والمحبة والوله لأبي عبد الله على نحو الحقيقة والطريقة المستقيمة، وانبعثت من احتراق الفؤاد، واشتعال نيران الأحزان في الأكباد، بمصاب هذا المظلوم ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله المصاب بتلك الرزية؛ بحيث تكون خالية ومبرَّأة من جميع الشوائب والتظاهرات والأغراض النفسانية؛ فلا يبعد أن يكون جائزاً.. وأغلب الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأُمور والكيفيات لا يأتون بها إلّا من باب التظاهر والمراءاة والتحامل والمداجات»[58].
وقد كان ـ في منظور الشيخ ـ أن أحسن الأعمال وأنزهها في ذكرى الحسين عليه السلام هو البكاء والندبة لريحانة الرسول صلى الله عليه وآله، والزيارة له والتبرّي من ظالميه والمشاركين في دمه وقاتليه والراضين بقتله[59].
3ـ كتاب جنة المأوى
يُعدّ كتاب جنة المأوى جمعاً لأبرز الأسئلة التي عُرضت على الشيخ كاشف الغطاء في قضية الإمام الحسين عليه السلام [60] وقضايا إسلامية أُخرى[61]، فضلاً عن بعض مقالاته المنشورة عن سيد الشهداء وفجيعة الطف[62].
زوّد الكتاب بكلمة مطوَّلة حررها الشيخ كاشف الغطاء في بني هاشم وبني أُمية، والحسن عليه السلام ومعاوية، وضمَّنها رأيه في أن العداوة بين هاشم وأُمية هي عداوة جوهرية ذاتية، يستحيل تحويلها، ويمتنع زوالها... والذاتي لا يزول، وليست هي من تنافس على مال أو تزاحم على منصب أو جاه، بل هي عداوة المبادئ، عداوة التضاد الطبيعي، والتنافر الفطري، عداوة الظلام للنور، والضلال للهدى، والباطل للحق، والجور للعدل[63].
وقد وجد الشيخ كاشف الغطاء في شغف النبي صلى الله عليه وآله وحبه الكبير للحسن والحسين عليهما السلام أبعاداً أُخرى قد تشمل أسراراً وأسباباً هي أدق وأعمق، أسراراً روحية فوق الوشائج الجسمية، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله ـ في نظر الشيخ ـ قد أطلَّ بروحيته المقدسة على صحيفة التكوين، فرأى ما كابد ولداه من الدفاع عن دينه، والحماية لشريعته... فالحسين عليه السلام قد استقبل السيوف والرماح والسهام، وجعل صدره ونحره ورأسه وقايةً عن المعاول التي اتخذها بنو أُمية لهدم الإسلام، ونصب نفسه وأولاده وأنصاره هدفاً لوقاية الإسلام من أن تنهار دعائمه، حتى سَلمَ الإسلام وأشرقت أنواره[64].
وقد جعل الشيخ كاشف الغطاء مهمة الحسين عليه السلام الرسالية في الحفاظ على شريعة الإسلام وجهاً من وجوه تفسير الحديث النبوي الشريف: «حسين مني وأنا من حسين»[65] الذي رفعه إليه أحد السائلين، بيدَ أنه جاء بتفسير آخر أعلى وأجل مما يرد في هذا المقام، وتدرَّج إليه بالقول: إن الولادة وانبثاق كائن من كائن تقع في الخارج على ثلاثة أنواع:
الأول: تولُّد جسم من جسم، كتولد إنسان من إنسان. وهذا هو التولُّد الجسماني المحض.
والثاني: تولُّد روح من جسم، كتولُّد أرواح البشر من أجسامها، كما تتكون الثمرة من الشجرة.
والثالث: تولُّد مجرد وروح من روح، كتولُّد النفوس الكلية من العقول الكلية في قوس النزول، وتولُّد العقول الجزئية من النفوس الجزئية في قوس الصعود. وقد قرَّر العرفاء الشامخون والحكماء الإلهيون أنه لا تنافي بين أن يتولّد شخص من آخر بالولادة الجسمية، ويكون الوالد متولِّداً من ولده بالولادة الروحانية، فآدم أبو البشر هو أبٌ للنبي محمد صلى الله عليه وآله بالولادة الجسمانية، لكنه متولِّد منه صلى الله عليه وآله بالولادة الروحانية، فآباء النبي صلى الله عليه وآله بالولادة الجسمية كلهم أبناؤه، وهي ولادة حقيقية أحق من الولادة الجسمية، وأن الولاية أوسع دائرةً وأعلى أفقاً وأكثر أثراً من النبوة: هنالك الولاية لله، وهي أول ولاية، أو الولاية الكبرى، وولاية النبي صلى الله عليه وآله وهي الولاية الوسطى، وولاية أوليائه من سدرة المنتهى وجنة المأوى.
ومن هنا؛ قالوا: إن الولاية أعم من النبوة، وكل نبي ولي ولا عكس، والنبوة تحتاج إلى الولاية، والولاية لا تحتاج إلى النبوة، فمعنى الحديث الشريف: هو حسين مني بالولادة الجسمانية، وأنا من حسين بالولادة الروحانية. فالحسين بوجوده الكلي الخارجي العيني لا الذهني هو الحائز بشهادته الخاصة، وإمامته العامة لمقام الولاية العظمى والفائز بالقدح الأعلى من سدرة المنتهى، وهذه هي مجمع الولايات وغاية الغايات؛ ومنها تتولَّد جميع النبوات؛ فلا جَرَمَ أن محمد النبي من الحسين الولي ونور النبوة ينبثق من نور الولاية ثم يصير النور واحداً[66].
ولعل ما كتبه الشيخ في تفسير جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله في سبطه هو مما تنصرف عن ذكره كثير من الأقلام؛ لأنه مما لا تحتمله عقول الأنام، أو من حديث العارفين الذين لا يرون نشره وذكره[67].
لقد كان الشيخ كاشف الغطاء يرى في موقف الحسين عليه السلام وأصحابه يوم الطف عملاً ربوبياً، ودروساً إلهيةً، وتعاليم روحيةً لأعقاب البشرية أملاها أكبر أُستاذ إلهي، مع سبعين نفراً من أهل بيته وخاصته، خاضوا لجج غمرات البلاء، وكانوا شُعلاً نارية ـ بل نورية ـ تسجل احتقار هذه الحياة مهما كانت شهيةً بهيةً، وتُبرهن على أنها مهما غلت وعزت فهي أرخص ما يُبذَل في سبيل المبدأ، وأهون ما ينبذ في طريق الشرف والكرامة، وسمو العقيدة ونبالة الذكر الخالد والمجد المؤيد، وليست القضية قضية تقابل بين مزاج يعمل للأريحية والنخوة، ومزاج يعمل للمنفعة والغنيمة، بل هو نزاع بين العقائد، عراك بين الكفر والإيمان، وحراب بين الشرك والتوحيد، بل بين الدين والجحود، والروح والمادة، والفضيلة والرذيلة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله في حروبه بدر وأُحُد والأحزاب قد ظفر بآل أبي سفيان بالغالبية، ففي حرب الحسين عليه السلام ويزيد يوم الطف ظفر الأول بالثاني بالمغلوبية؛ فصار المقتول هو القاتل، والمغلوب هو الغالب[68].
ويُوجِّه الشيخ كاشف الغطاء عِبْرَ هذا النص ـ الذي يرى في صراع الحسين عليه السلام صراعاً بين الدين والجحود ـ نقداً للعقَّاد، وإن لم يُصرِّح باسمه؛ لأن العقّاد رأى مدار الخلاف في الجولة التاريخية بين الحسين عليه السلام ويزيد بن معاوية هو الفارق بين مزاجين بارزين، هما الأريحية التي كان يمثلها الحسين عليه السلام وأصحابه، والنفعية التي تتجلّى في يزيد وأنصاره[69].
لقد وُجِّه إلى الشيخ كاشف الغطاء سؤالٌ عن الأخبار الواردة بتكلُّم رأس الحسين عليه السلام غير مرة، وهل يمكن أن تقع تلك المعجزة بمرأى الناس دون أن يرتدعوا أو يغالوا؟[70]، وقد جاءت إجابته على تلك الكرامة أنها على تقدير صحة وقوعها لم تقع بمرأى من عامة الناس، وإنما هي خصوصية لبعض الأفراد الناقلين لها لحكمة، إما مجهولة لنا، أو معلومة، وعلى تقدير وقوع شيء من ذلك بين أُمة من الناس وجمهرة من البشر، فلا يلزم من ذلك أن يرتدعوا، فكم وقعت من الأنبياء معجزات بين أممهم فلم يرتدعوا حتى أصابهم العذاب... وقد ورد في الأخبار المعتبرة أن رأس يحيى بن زكريا تكلَّم بعد قتله مع الجبَّار الذي أمر بقتله؛ فالحرص والشهوة والطمع إذا استحكم في النفس وصار لها خلقاً وطبعاً لم يكن شيء من العبر والعظات مؤثراً فيها؛ فإذا شاهدت النفس تلك الغرائب انصرفت عن التفكر فيها وترتيب الأثر عليها، أو تصرَّفت فيها بالتأويلات عن وجه الحقيقة، وإنّ أُمةً تقتل عترة نبيها وتسبي عياله لا يُستبعد عليها جحود معجزة له أو كرامة[71].
لقد رصد الشيخ في جوابه هذا أدلة دينية، واستوحى الواقع الاجتماعي من المثل التاريخي في نبوات الأنبياء، وربط ذلك مع الطبيعة البشرية عندما تتحكَّم فيها الأهواء، ومما يعضد إجابته أن بعض المعجزات النبوية لم يكن ظاهراً لعموم الناس، ولا في كل الأوقات، كتظليل الغمام على رأس النبي صلى الله عليه وآله، والتي كانت ظاهرة لبعض الناس دون بعض، ويظهر ذلك واضحاً لمن تتبّع وتأمّل معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته[72].
لقد تعجَّب أحد الناس في سؤال رفعه إلى الشيخ كاشف الغطاء من فعل الحسين عليه السلام مع أصحابه عندما قال لهم: إنكم في حل من بيعتي بينما كان الجهاد معه واجباً[73].
وقد أجاب الشيخ، وهو يعكس الإشكالية إلى محل آخر أكثر عجباً، وهو كيف أباح لهم الحسين عليه السلام الجهاد معه وهو يعلم أنهم لا يستطيعون دفع القتل عنه، مهما جاهدوا واجتهدوا؟! فكيف رضي منهم ذلك؟! ألا يكون جهادهم معه من العبث وإلقاء النفس في التهلُكة بغير فائدة؟! هكذا تساءل الشيخ كاشف الغطاء، وهو يعدُّ السرَّ الغامض الذي يحتاج إلى البحث والنظر[74] ولم يقدم له جواباً.
وقد يكون توقُّف الشيخ عن إعطاء الجواب حول هذه الإشكالية التي طرحها هو نظرته إلى الثورة الحسينية، وأنها مما لا يُحاط بمزاياها وخفاياها وأسرارها، وهو ما دفعه إلى أن يُشبِّه الحسين عليه السلام بكتاب الله، فالقرآن ـ على كثرة تفاسيره وشرح دقائقه وغوامضه وبلاغته ـ لا يزال كنزاً مخفيّاً، ولا تزال محاسنه تتجدّد وأسراره تتجلّى، ويظهر في كل عصر من إشاراته ومغازيه ما لم يظهر للمتقدِّم، فكأنه يتجدّد ويتطوّر بتطوِّر الزمان، وكذلك الحسين كتاب الله الناطق[75].
ومع ذلك يبدو غريباً ألَّا يُجيب الشيخ عن هذا الإشكال، وهو المعروف بأعلميته العلمية، وقابليته على الاستنباط والتحليل، ناهيك عن أن «التاريخ من صُنْعِ الإنسان أفراداً وجماعات، ولا تجري حوادث التاريخ بصورة عفوية آنية، وبدون ارتباط بالحوادث السابقة، فحوادث التاريخ مترابطة؛ لذلك لا بد في العمل السياسي لأجل الوصول لغاية معينة من العمل المستمر والجهاد المستمر، فالتضحية في سبيل الحق ـ على اختلافها ـ وإن لم تكن ذات فائدة آنية، فإنها تُثمر في المستقبل، خصوصاً الشهادة في سبيل الحق؛ فإنها تُنبِّه الأفكار، وتُهيج النفوس لطلب الثأر ومواصلة الكفاح للوصول إلى الهدف والغاية... وقد ظهرت على مرّ القرون آثار تضحية الحسين عليه السلام وأعوانه...»[76].
إن تَفَرُّدَ أبطال الحق هو انتماؤهم العظيم للتضحية والحق، وقد أوضحت كربلاء شرف التضحية على نحو باهر وجليل، حتى لنظن أن الأقدار إنما أرادت ذلك اليوم بكل أهواله وتضحياته؛ لتؤكد شرف التضحية في وعي البشرية كلها؛ ليضيء بمغزاه العظيم ضمير الحياة؛ من أجل ذلك اختارت لها ـ في يوم كربلاء ـ نماذج رفيعة بالغة الرفعة، وقضية عادلة، بالغة العدالة، ونضالاً باسلاً بالغ البسالة[77].
4 ـ نبذة من السياسة الحسينية
اندفع الشيخ كاشف الغطاء إلى تأليف هذا الكُتيب، بعد أن عُرِض عليه سؤال لمُشكِّك ناقد، يرى أن الحسين عليه السلام إذا كان عالماً بقتله في خروجه إلى كربلاء وسبي عياله، فقد عرَّض بعِرْضِه إلى الهتك، وليس في تعريضه هذا شيء من الحُسن العقلي المعنوي يوازي قُبح الهتك[78]؟
وقد جاءت إجابة الشيخ مفصِّلةً لجانب واحد، وهو الرد على قول السائل: بأن في السبي هتك لحرم النبوة. فيما ترك رحمه الله الجانب الأول من السؤال، وهو: ما إذا كان الحسين عليه السلام عالماً بقتله في خروجه إلى كربلاء. ولعل ذلك يعود إلى أن الشيخ يعدُّ ذلك من المسلَّمات[79].
وقد ركَّز إجابته في حوالي 37 صفحة[80]، ويُعدّ هذا الكُتيب من أوسع ما كتبه الشيخ كاشف الغطاء حول قضية واحدة مما يُثار حول ثورة الحسين عليه السلام ، حسب ما اطَّلع عليه الباحث ووصل إلى يده.
ومما تجدر الإشارة إليه أن التعريف بهذا الكُتيب قد جاء مغلوطاً في رسالتَيْ ماجستير تخصصَّتا في دراسة شخصية الشيخ كاشف الغطاء وأدواره الوطنية والقومية والإصلاحية؛ فقد قدمه السيد سلمان على أنه: دراسة تاريخية لثورة الإمام الحسين[81]. وعرضته باحثة أُخرى على أنه إجابة عن وجه إقدام سيد الشهداء عليه السلام على الشهادة[82]. وكلا التعريفين لم يصب الحقيقة التي ذكرها الباحث آنفاً.
لقد أحال الشيخ كاشف الغطاء الإجابة عن سبي حرم الحسين عليه السلام إلى أحد أولاده، ولمّا وجد الإجابة لا تنقطع بها المسألة تصدّى إلى إملاء الجواب على ولده في أوقات الفراغ، وفي عدّة مجالس[83]. وهذا يعني انفساح الوقت لمزيد من التأمل بالرد، وتشريح البيان، وحشد ما لديه؛ لتزاح به الشبهة.
لقد تسلسل الشيخ في ردّ السائل بأساس الإشكال الذي يقع فيه المتشكك إذا لم يكن على مذهب الإمامية من حيث القول بعصمة الأئمة، وهو أصل لم يُفصّله الشيخ طالما أنه من عقائد الشيعة المدعومة بالحجة والبرهان، وأورد تشبيهاً يسهل فهمه لعصمة الأنبياء، ومن ثم الأئمة، فقال: «فليس مَثَلهم عندنا ـ في مناهجهم الخاصة وأعمالهم التي تصدر عنهم طول حياتهم بين البشر ـ إلّا كمثل رجل عرف منه الملك تمام الكفاءة، وأحرز منه صدق الطاعة، فأرسله سفيراً إلى قوم... يقوم فيهم بالإرشاد والهداية، وزوّده بمنهاج مخصوص، وألزمه ألّا ينحرف عنه قيد شعرة... وليس له حق السؤال والمراجعة عن الحكمة والمصلحة بعد أن كان من اليقين على مثل ضوء الشمس»[84].
وقد لا يكون هذا التفسير الديني دليلاً للمُشكّك الذي ليست عقيدته في الحسين عليه السلام كما هي عند الإمامية؛ ولذلك افترض أن الحسين عليه السلام ـ كما يفترضه السائل ـ زعيم من زعماء المسلمين، يرى نفسه أوْلى بالخلافة من يزيد؛ فلا جَرَمَ أن يبذل ما في وسعه لاستعادة حقه، وعلى الأقل أن لا يبايع يزيد مع ما هو معلوم من مجاهرته بإحياء كل رذيلة و«هل من سبيل إلى الكشف عن نفسية يزيد، وخسة طبعه، وعدم أهليته من حيث لؤم عنصره وخبث سريرته وقبح سيرته، مع قطع النظر عن الدين والشرع ـ أقرب وأصوب وأعمق أثراً في النفوس عامة والعرب خاصة والمسلمين بالأخص من هتك حرم النبوة وودائع الرسالة، وحملهم أُسارى من بلد إلى بلد، ومن قفر إلى قفر، وهل أعظم فظاعة وشناعة من التشفّي والانتقام بالنساء والأطفال بعد قتل الرجال؟! وأيُّ ظَفَر وغلبة على يزيد أعظم من إشهار هذه الجرائم عنه؟»[85].
ويلتفت الشيخ إلى الواقع التاريخي للمجتمع الإسلامي الذي عاصره الحسين عليه السلام من حيث اعتياد القتل، فهو أمر متعارف في البيئة العربية آنذاك، لا يُثير غرابة أو فضاعة، فإن كان يزيد وعبيد الله بن زياد مستعدَّين لتلك الجريمة؛ فإنه أراد أن يُبرزها منهما إلى الوجود[86].
ومما يضاف هنا: أن القتل كان قد أصبح في عهد بني أُمية أمراً ميسوراً للتخلص من المعارضين، دون أن يُثير ذلك حركة واسعة في المجتمع الإسلامي ضدهم، ولعل في قتل حجر بن عدي مثلاً صارخاً لذلك[87].
وقد أكد الشيخ كاشف الغطاء أن وسائل الحسين عليه السلام لفضح يزيد لم تنحصر بحمله للنسوة والأطفال، إلّا أنها كانت إحدى الوسائل التي لها التأثير الكبير في المقصود[88].
ولم يُهمل الشيخ ـ وهو يُحشِّد ردوده ـ أن يتّجه بالجواب اتجاهاً فقهياً، فإن قال السائل: إنه لا يجوز في الدين أن يُعرِّض الحسين عليه السلام نساءه للهتك مهما كان الأمر؛ فإن هذا ما ينبعث من بساطة التفكير لدى السائل؛ فإن الذي «لا يساعد عليه الدين ـ بل ولا تسمح به الغيرة ـ هو تعريض الإنسان عرضه للهتك الموجب لما يمسّ الشرف، ويخدش رواق العفة والصيانة، وسرادق النجابة والحصانة، أما الهتك الذي تستحكم به عرى القدس والطهارة والعزة والمنعة؛ ذلك مما لا يُشين ولا يُهين تلك الحرائر صلوات الله عليهن مهما سفرن فهنّ محجبات..»[89].
اتجه الشيخ فيما سطّره إلى حشد وجوه عديدة للجواب، فإن لم يقنع بها السائل، كان هناك وجه آخر، حتى أنه حاول أن يستوفي تلك الوجوه مناهج البحث العلمي الرصين، الذي كان له حظه من المصداقية والدقة. فاستخدم المنهج الاستقرائي للوصول إلى حقيقة أُخرى، فأشار إلى حياة الحسين عليه السلام في أدواره وأطواره، وربط ما وصف به من الشمم والشهامة، وعزة النفس والإباء والكرامة مع طريقة خروجه إلى كربلاء، ووصل إلى أمر مفاده: أن نفسه عليه السلام أبت أن يخرج هو وولدانه وغلمانه على ظهور خيولهم خروج المتشرد الخائف، والنافر الفزع، ولم يرضَ لنفسه إلّا أن يظهر بأسمى مظاهر الأُبهة والهيبة والجلال والحشمة، فإن خرج سلام الله عليه من أوطانه وترك عقائله في عقر دارهم لكان خروجه أشبه ما يكون بصعاليك العرب وأهل الغزو والغارات والمتلصصين، وحاشا لسيد الإباء أن يرضى لنفسه بتلك المنزلة[90].
واستدل على ضخامة موكب الحسين عليه السلام مما ذكر في كتب التاريخ من أنه دعا فتيانه إلى سقي الحر الرياحي الذي جاءه محارباً مع1000 فارس[91]، فكم كانت سعة موكبه؟ وكم كان يحمل من الماء حيث سقى ألف فارس وألف فرس سوى مَن كان معه من أولاده وعياله وأنصاره؟ وقد قدر الشيخ أن معسكر الحسين عليه السلام كان يحمل ما يروي ستة آلاف نسمة أو سبعة آلاف نسمة، بعد أن قدر أولاده وأنصاره وعيالاتهم بألف نسمة، وحمولة خيامهم وأمتعتهم وما إليها نحو ألفين من الخيل والبغال غير الإبل[92].
وقد سلك الشيخ مسلك المبالغة في عدد مَن يُقتل في معسكر أعداء الحسين عليه السلام بيد أنصاره، وجعل الواحد منهم لا يُقتل حتى يَقتل ألفاً من عدوه[93]، وكأنه أراد أن يُحقّق عبر هذه المقابلة معادلةً ذكرها دون تدقيق، وهي أن أصحاب الحسين عليه السلام كانوا سبعين رجلاً، ومعسكر أعدائه كان سبعين ألفاً[94]؛ إذ ذكرت الروايات التاريخية الدقيقة: أن الجيوش التي أُرسلت إلى الحسين عليه السلام في كربلاء لم تزد على اثني عشر ألفاً[95]، وإذا كانت بعض المصادر بالغت في عدد الحشود التي توجّهت لقتال الحسين عليه السلام فلا يمكن الركون إلى أن الكوفيين تألّبوا جميعاً ضده، لا سيما وأن قسماً من الذين لم يحسبوا في ولائهم على أتباع الحسين عليه السلام قد أظهروا التأثم من القتال، وكرهوا البقاء في الكوفة؛ لئلّا يُجبروا على القتال ضده أو معه[96].
لقد استفاد الشيخ كاشف الغطاء من الاطلاع على التاريخ الإسلامي، وتقاليد العرب قبل الإسلام لتفسير موقف الحسين عليه السلام بأخذ عيالاته معه إلى كربلاء من وجه آخر، وهو ما كانت العرب عليه من أنهم إذا أرادوا أن يستميتوا في الحرب ويصبروا للطعن والضرب جعلوا الحريم خلفهم واستقبلوا العدو، فإما الحتف أو الفتح، ويستحيل عندهم النكوص أو الفرار وترك الحريم للذل والإسار.. ومنها ما وقع لثقيف وهوازن في غزوة حنين، فلعلّه عليه السلام حمل العيال كي يستميت أصحابه دونها، وينالوا درجة من السعادة بالشهادة كما فعلوا[97].
وقد رجح الشيخ من تلك الوجوه العديدة التي قدمها مفسراً بها حمل الحسين عليه السلام نساء بيت النبوة معه، أن الحسين عليه السلام كان يعلم بمصرعه، ومن معه، وأن بني أُمية سيموّهون على خروجه ويصفونه بالباغي الذي خرج على يزيد المُنصّب بالاستخلاف من الخليفة الذي قبله[98]. لا سيما وأن الدعاية كان من الممكن أن تشقّ طريقها في ذلك المجتمع الخائف الخاضع لبني أُمية.
من هنا؛ كان لعيال الحسين الدور المهم في إبراز الحقائق وكشف دعايات الأعداء المغرضة.
ومما لا شك فيه أن الشيخ كاشف الغطاء قد تمتع بقوة الاستدلال، واستثمار الحادثة التاريخية التي تمنح الباحث عن الحقيقة رؤية دقيقة للواقع الاجتماعي والسياسي؛ ففي سياق ترجيحه لوقوف الحسين عليه السلام بوجه الدعاية الأُموية كتفسير أقرب إلى القبول من بين الوجوه التي عرضها، مع ذلك وضّّح أنه لم يكن من السهل على أكبر رجل باسل أن يقف ليكشف الحقيقة، ويتعقب القضية، ويخطب في النوادي الحاشدة كما فعل أهل بيت النبوة، كالسيدة زينب عليها السلام والإمام زين العابدين عليه السلام ، واستدل على ذلك بما جرى على عبد الله بن عفيف[99]، وزيد بن أرقم[100] لمّا اعترضا على عبيد الله بن زياد في مجلسه؛ إذ مُنعا من الاعتراض ولوحق أحدهما حتى قُتل، بل رغب عبيد الله بن زياد في قتل الإمام زين العابدين عليه السلام . فعلى مَن يعتمد الحسين عليه السلام في تفنيد ضلالة الأُمويين؟ ومَن «يقوم للحسين بهذه المهمة بعد قتله، ومَن ذا يقرع بالحجة، ويوضح المحجة، ويكشف الحقيقة، ويتعقب القضية، ويخطب.. تلك الخطبة البليغة والحجج الدامغة؟»[101].
ثم أيّ رجالات ذلك العصر كان يقدر على القيام بتلك المهمة، ويقوى على النهوض بذلك العبء؟ أليس قصارى أمره مهما كان من البسالة والجرأة أن يقول الكلمتين والثلاث، فيقال: خذوه فاقتلوه. أو اصلبوه في السبخة، أو في الكناسة[102]. كما حصل مع ابن عفيف.
لذا؛ فإن الإمام الحسين عليه السلام لم يجد بُدَّاً من حمل نساء بيت النبوة؛ معه لإكمال ذلك المشروع الذي بذل نفسه ونفوس أعزته في سبيله، وعلم أن بني أُمية مهما بلغوا من هتك الحرمات، والشرائع الإسلامية والتجاوز على الشناشن العربية، لا يقدرون على قتل امرأة مُصابة مفجوعة تكلمت بشيء من الكلام تبريداً لغلتها وتسكيناً للوعتها، ولا يستطيع ابن زياد مهما طغى أن يقتل ساعة السلم امرأة عزلاء أسيرة بين يديه لا تحمل السلاح[103].
كان الشيخ بارعاً في توليد الاستدلال، فالدليل يقود إلى آخر؛ فقد جعل من محاولة عبيد الله قتل زين العابدين عليه السلام ـ وهو أسير لا يجوز عليه القتل ـ دليلاً على قسوة السلطة الأُموية في قمع بواعث النقمة وكمِّ الأفواه، وعقل الألسن، وإرجاف القلوب، ولكن مشيئة الله وقضاءه، وتعلق السيدة زينب عليها السلام به أمام ابن زياد، وإصرارها على أن تُقتل قبله كان سبباً في حفظه، وقد يكون هذا وجهاً آخر من وجوه غاية الحسين عليه السلام من حمل عياله معه إلى كربلاء[104].
لقد اتخذ الشيخ كاشف الغطاء من استعراض خطب السيدة زينب عليها السلام بأُسلوب مشوِّق سبيلاً لحمل الشخص السائل إلى الإيمان بأهمية موقفها؛ إذ بيَّنت ذلّة الباطل، وعزّة الحق، وعدم الاكتراث بالقوة والسلطة، أرادت أن تعرّفه والناس جميعاً جميل النظر في العاقبة، وأن الأُمور بعواقبها والأعمال بخواتمها[105].
ولا شك في أن الشيخ أراد هنا أن يُركّز على أهمية الخطابة ـ التي تؤثر في العقول وتُثير العواطف ـ في تهييج الرأي العام، وتكوين الانقلابات والثورات، وهو أمر آمن به الشيخ وجعله الأُسلوب الأول من أساليب العمل ضد الظلم في كتاب آخر[106]؛ ولذلك رأى أنه «ما قلب الفكر على بني سفيان، وانقرضت دولة يزيد بأسرع زمان إلّا من جرَّاء تلك الخطب والمقالات... فقد تسلسلت الثورات... على يزيد من بعد فاجعة الطف إلى أن هلك»[107].
والملفت أن الشيخ كان يرى أن للجنس اللطيف ـ كما يُسميه ـ القدرة على أن يقوم بأعمال كبيرة، يعجز عنها الجنس الآخر، ولو بذل كل ما في وسعه، وأن له التأثير الكبير في قلب الدول، وتحوير الأفكار، وإثارة الرأي العام[108]. وموقف السيدة زينب عليها السلام دليل على ذلك.
ولا يفوت الباحث الإشارة إلى أن الشيخ كاشف الغطاء ـ وهو يتصدّى لمهمة الإصلاح الاجتماعي ـ لم ينسَ دور المرأة الفاعل في نهضة المجتمع، فكان يخاطبها وهو يستلهم دروس الثورة الحسينية: «نقول للحرائر النجيبات: إننا نطلب منهن الشجاعة الأدبية، نطلب منهن الثورة على الظلم والظالمين، وتتابع الصرخات على المستعمرين، ومحاسبة المسؤولين»[109].
ويظهر لقارئ هذا الكتيب الصغير ـ جلياً ـ قابلية الشيخ كاشف الغطاء على فهم الحدث التاريخي، واستنباط وجوه ذات مداليل متعددة من الحدث الواحد، وعدم الركون إلى التفسير الأُحادي، مع قابلية على الترجيح والربط، واستخدام أكثر من منهج كالمنهج العلمي، والاستقرائي، والرياضي، والمقارن، فضلاً عن استخدامه للغة أدبية راقية ومفهومة، يميل فيها أحياناً إلى السجع[110]، والتلوين بأبيات شعرية تخدم مقاصده العلمية[111]، أو بجمل اعتراضية للتعليق والتوضيح[112].
وقد اتّبع أُسلوب الوصف البليغ أحياناً؛ لتجسيد الصورة وتقريب المعنى، مثل وصفه لدخول السبي من آل بيت النبوة إلى الكوفة والشام[113]؛ وتميز بالتبسّط في المحاورة ومحاولة إشراك الناقد والمشكك في النظر إلى الدليل؛ ليشترك معه في الإجابة[114].
5ـ مراثي الشيخ كاشف الغطاء في الحسين عليه السلام
تفجرت ينابيع موهبة الشيخ كاشف الغطاء الشعرية، وله من العمر اثنتا عشرة سنة، ونظم القصائد الطوال وهو في سن الثالثة عشرة، وعلى الرغم من قلّة شعره المنشور؛ فإن ذلك لم يمنع الشيخ من احتلال المكانة البارزة بين شعراء العراق المحدثين، وروّاد النهضة فيه، وأن يدور اسمه على ألسنة الأُدباء والدارسين في المجالس، فهو يُعدّ من الشعراء الذين تصدّوا لسياسة المستعمرين ليس في العراق فحسب، بل في العالم الإسلامي كله[115].
وكان لسيد الشهداء عليه السلام مكان في مراثي الشيخ، إذ كان له «عشر قصائد في رثاء الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام »[116]، وقد نُشرت في كتاب مقتل الحسين عليه السلام سبع قصائد شعرية مطولة، اختصت الست الأُوَل منها برثاء الحسين عليه السلام ، وبلغت الأُولى: 69 بيتاً، والثانية:78 بيتاً، والثالثة: 44 بيتاً، والرابعة: 80 بيتاً، والخامسة: 42 بيتاً، والسادسة: 39 بيتاً، بينما كانت السابعة في رثاء علي بن الحسين عليه السلام ، وخص بها الحسين عليه السلام بحوالي: 29 بيتاً؛ فيكون مجموع المنشور له في رثاء الحسين حوالي 381 بيتاً شعرياً مما ورد في كتابه مقتل الحسين[117].
وقد استطاع عبر هذه القصائد الطوال أن يجمع تفاصيل مأساة الطف، «وما جرى فيها من مصائب وأحداث، بحسب الترتيب الزمني لوقوعها، بصورة تُشبه ما اعتاد عليه خطباء المنبر الحسيني في عرضهم لواقعة الطف، وذكر مقتله الذي كتبه الشيخ في كتاب مقتل الحسين عليه السلام لكي يجمع بذلك فضل ذكر واقعة كربلاء شعراً ونثراً»[118].
فنراه يبدأ بذكر الدوافع التي دفعت الإمام الحسين عليه السلام إلى القيام بثورته وكيفية مغادرته الحجاز وذهابه إلى العراق[119]، حتى وصوله إلى مكان الفاجعة كربلاء؛ ليستوحي من اسمها ما حل بآل النبي صلى الله عليه وآله، فقال[120]:
ضربوا بعرصة كربلاء خيامهم فــأطـل كــربٌ فـوقهـا وبلاء
لله أيّ رزيـة في كـــربـــلاء عظمت فهانت دونها الأرزاء
واستذكر شجاعة الحسين عليه السلام ، فقال[121]:
يــطارد منهـم سبعين ألـفاً طراد الضاريات قـطيع شاء
سـطـا غـضـبـان فانهزمت نجاء تـظن لها نجاة بالنجاء
تطير قلوبهم رعـباً وضرباً رؤوسـهـم تطـاير في الهواء
كما وصف استسلام الحسين عليه السلام لقضاء الله[122]، حتى قضى شهيداً تقطّع كبده من العطش، فقال[123]:
تــفــطّر قـلبـه ضـمـأ وتـروى بـــه عــسـالـة الأســل الظماء
فوا لهفي خضيب الشيب يُمسي عـلى ضــمـأ غــريـقـاً بـالدماء
وفي مكان آخر يقول[124]:
ظـام تـفـطّر قلبه ضمأ وبالـ حملات منه ترتوي الغبراء
تبكي السماء دماً له أفلا بكت مـاءً لـغـلـة قـلـبه الأنواء
وقد تلهّف على الحسين عليه السلام وهو يصف بقاءه على الأرض ثلاثة أيام بلا دفن وبلا رداء، فقال[125]:
ويــا لهـفـي عـليك أبا علي عن الأهلين والأوطان نائي
ويا لهفي عليك وأنت ملقًى عـلى الـغـبرا ثـلاثـاً بالعراء
ويا لهفي لجسمك والعوادي تجول عـليـه مسلوب الرداء
وتفجّع على ما أصاب عيال الحسين عليه السلام بعد استشهاده من سلب وإضرام نار، وذعر على أيدي أعدائهم، فقال[126]:
أأنسى دماءً قد سُفكن وأدمعاً سُكبن وأحراراً هُتكن من الحجب
أأنسـى بـيوتاً قد نُهبن ونسوةً سُـلـبن وأكـبـاداً أُذين من الرعب
أأنسى اقتحام الظالمين بيوتكم نــزوع آل الله بـالضـرب والنهب
أنسى اضطرام النار فيها وما بها سوى صبية فرّت مذعرة السرب
وقد صوّر موقف السيدة زينب عليها السلام شعراً عندما خرجت مذعورة، تجهش بالبكاء[127]، ويصف فجيعتها التي تُزلزل الرواسي، فيقول[128]:
وتنعى فتُسجي الصمّ زينب إذ نعت
وتصدع شكواها الرواسي من الهضب
ثم يُذكّر بما مرّ على بنات الرسالة من أسر وسبي، فيقول[129]:
وفي الأسر كم من بنت وحي سروا بها
إلى الشام فوق المزعجات الدلايث
ولم ينسَ وهو يرثي سيد الشهداء عليه السلام أن يتألم لرأسه الشريف، وهو يُهدى إلى يزيد في الشام، فيقول[130]:
ويا مسيح هدى للرأس منه على الـ رماح معراج قدس راح يعرجه
ويا كليماً هوى فوق الثرى صعقاً لـكن محيــاه فوق الرمح أبلجه
وقد كانت نفس الشيخ كاشف الغطاء تذوب وهو يستذكر أن بني أُمية قد نالت من الحسين عليه السلام ، ومثّلت برأسه، فيقول[131]:
واحــرّ قـلبي يا بن بنت محمـد لك والعدى بك أنجحت طلباتها
وعلى الثنايا منك يلعب عودها وبـرأسك الســامي تُشــال قناتها
وقد ظل الشيخ يبثُّ لواعجه على مصائب أهل بيت النبوة، ووعد في إحداها أن يظل نائحاً ما عاش، حتى إذا ما أخذه الموت ورثها وارثه:
يـمـيناً بني الهــادي بفرقان جدكم ومـا أنـا بالفرقان يوماً بحـانث
لقد غُرست أرزاؤكـم في حشاشتي من الوجد أفنان الشجون الأثايث
مصائب قد أشجتني وصيرن مقولي ينوب لكم من كل رقشاء نافث
مراث تُذيب الصخر إن عشت نحتكم بهن وإن أهلك يرثهن وارثي[132]
لقد جسد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء واقعة الطف وأحداثها بتفاصيل متسلسلة، ركّز فيها على الجانب المأساوي، موضحاً مكانة الإمام الحسين عليه السلام ، وأصحابه ومواقفهم وشجاعتهم وتضحياتهم، وكان الشيخ يجعل من رثاء الإمام الحسين عليه السلام في بعض الأحيان منطلقاً لبثّ ألمه وشكواه ودعوته للنهوض وأخذ الثأر[133].
[1] آل كاشف الغطاء، عبد الحليم، مقدمة كتاب في السياسة والحكمة: ص10.
[2] قرية من قُرى الحلة، يقال لها قديماً: قناقية، ويلفظها العرب جناجية على قاعدتهم في إبدال القاف جيماً. اُنظر: آل كاشف الغطاء، جعفر، مقدمة كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: ص1ـ 6.
[3] اُنظر: كاشف الغطاء، محمد حسين، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية: ص12. كاشف الغطاء، مقدمة كتاب في السياسة والحكمة: ص10.
[4] اُنظر: كاشف الغطاء، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية: ص55. السيد سلمان، حيدر نزار عطية، الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ودوره الوطني والقومي: ص31ـ32.
[5] اُنظر: محبوبة، محمد جعفر، ماضي النجف وحاضرها: ص3ـ183. وللاطلاع على توجه أُسرة آل كاشف الغطاء وعلمائها ينظر: التكريتي، منير بكر، أساليب المقالة في الأدب العراقي الحديث والصحافة العراقية: ص261.
[6] اُنظر: الخاقاني، علي، شعراء الغري النجفيات: ص10ـ100؛ السيد سلمان، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص34.
[7] اُنظر: السيد سلمان، الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء: ص50.
ومما له دلالته على الحركة العلمية والثقافية التي نشطت في النجف بتأثير النهضة الحديثة تأسيس جماعة من الأهالي عام 1327هـ/ 1909م هيئة علمية، اشترك فيها علماء الدين وعدد من التجّار، أخذت على عاتقها إنشاء مدارس لتدريس العلوم الحديثة واللغات الأجنبية، ولا ريب في أن لذلك دوراً كبيراً في حركة التجديد ونشر الأفكار الحديثة. اُنظر: الأسدي، حسن، ثورة النجف: ص79.
[8] كاشف الغطاء، محمد حسين، الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية: ص1ـ20.
[9] تعلم الشيخ أيام صباه وشبابه ـ كما هي الطريقة الجارية في مدينة النجف ـ النحو والمنطق، وعلم البلاغة، والفقه وأُصوله، والحكمة والكلام، والرياضيات، وتوسَّع في العربية: من شعر ونثر وخطب، وحضر على أكثر مشاهير عصره من الأعلام. اُنظر: كاشف الغطاء، مقدمة كتاب في السياسة والحكمة: ص11.
[10] اُنظر: هيدان، نوره كطاف، الفكر السياسي للشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد: ص24.
[11] كاشف الغطاء، مقدمة كتاب في السياسة والحكمة: ص7ـ8.
[12] لمزيد عن نشاطه الوطني اُنظر: السيد سلمان، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص79 ـ130. هيدان، الفكر السياسي: ص28ـ32.
[13] فضلاً عن دفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، فقد أفتى بوجوب الجهاد في فلسطين بالأرواح والمال؛ لتخليصها من الاحتلال الصهيوني سنة 1368هـ، 1948م، وأبرق للحكومة الإيرانية داعياً إياها للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. اُنظر: كاشف الغطاء، محمد حسين، الخطب، جمعها: عبد الحليم كاشف الغطاء: ص77 ـ 79. كاشف الغطاء، في السياسة والحكمة: ص15، ص49، ص60، ص65 ـ 66.
[14] كاشف الغطاء، الخطب: ص151.
[15] اُنظر: كاشف الغطاء، محمد الحسين، المُثل العليا في الإسلام لا في بحمدون: ص86ـ88.
[16] اُنظر: السيد سلمان، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص155. واُنظر: خطبة الشيخ في المؤتمر الإسلامي الباكستاني المنعقد في كراتشي العاصمة الباكستانية سنة 1372هـ/ 1952م: ص2ـ 8.
[17] اُنظر: كاشف الغطاء، مقدمة كتاب في السياسة والحكمة: ص14ـ15. الغريري، سامي، محمد الحسين كاشف الغطاء أحد روَّاد التقريب، بحث منشور في كتاب الحوزة العلمية العراقية والتقريب: ص213.
[18] اُنظر: الغريري، محمد الحسين كاشف الغطاء أحد روّاد التقريب، ص213.
[19] اُنظر: جواب الشيخ كاشف الغطاء في الوثيقة المنشورة ضمن كتاب المُثل العليا في الإسلام: ص99.
[20] اُنظر: المصدر السابق.
[21] مثل صحيفة الاستقلال، وصوت الأهالي، والأخبار، والزمان، والشعب، والحساب، والوادي في العراق، والعرفان، والهدف، والتلغراف، وبيروت المساء، والصرخة في لبنان.
[22] اُنظر: نصوص تلك المقالات والرسائل التي وصلت إلى الشيخ ضمن ملحقات كتاب المُثل العليا في الإسلام لا في بحمدون، تحت عنوان: صدى الكتاب في العالم العربي والإسلامي: ص102ـ 119.
[23] ذكر نجل الشيخ محمد شريف آل كاشف الغطاء أن مؤلفات والده تزيد على الثمانين مؤلفاً. اُنظر: مقدمة الطبعة الرابعة عشرة لكتاب، أصل الشيعة وأُصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة: ص4.
[24] ومما يُشار إليه في المقام هو أن بعض مؤلفات الشيخ رحمه الله مفقود ولم يُعثر عليه. اُنظر استعراض مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة، كما وردت لدى السيد سلمان، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص57ـ65.
[25] اُنظر: آل كاشف الغطاء، مقدمة الطبعة الرابعة عشرة لكتاب أصل الشيعة: ص4.
[26] أصل الشيعة وأُصولها: ص15.
[27] اُنظر: أمين، أحمد، فجر الإسلام، ط7، القاهرة، 1375هـ/ 1955م، ص 276، وينظر: ص111 ـ 112، ص 274 ـ 275، ص277 ـ 278.
[28] ورد هذا التقويم في رسالة العلامة أحمد زكي التي أرسلها من القاهرة إلى ناشر كتاب أصل الشيعة وأُصولها السيد عبد الرزاق الحسيني. اُنظر: أصل الشيعة وأُصولها: ص21.
[29] ذكر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في نهاية كتابه: نبذة من السياسة الحسينية، ص34. ما نصه: «لقد كنت أتمنّى منذ عشرين سنة أن أنتهز من عمري فرصةً وآخذ من مزعجات أيامي مهلةً لأكتب كتاباً في دقايق السياسة الحسينية وأسرار الشهادة بما لم يكتبه كاتب، ولاحام حول شيء منه مؤلف، ولا تفوّه ببعضه إلى اليوم خطيب، ولكن حوادث الأيام وتقلُّبات الصروف لا تزال تدفعني، من محنة إلى محنة، ومن كارثة إلى كارثة».
[30] اُنظر: نص رسالة أحمد بدران، مترجم مديرية الميناء الذي عرض على الشيخ رغبة المستشرق، كما وردت في مقدمة كتاب: الأرض والتربة الحسينية: ص8 ـ 9.
[31] المصدر السابق: ص22.
[32] المصدر السابق: ص22ـ23.
[33] المصدر السابق: ص29ـ31.
[34] المصدر السابق: ص33.
[35] المصدر السابق: ص34.
[36] المصدر السابق: ص34.
[37] المصدر السابق: ص35ـ 36.
[38] ومن أمثلة ذلك: أن الأرض يحملها حوت أو ثور، ويضعها على قرنه، فإذا شاء أن تكون في الأرض زلزلة حرك قرنه؛ فتزلزل الأرض.
اُنظر: ما ذكره من شواهد لهذا وأمثاله في الكتب الشيعية، المصدر السابق: ص45ـ 47.
[39] كاشف الغطاء، محمد حسين، مقتل الحسين عليه السلام : ص10.
[40] اُنظر: كاشف الغطاء، محمد شريف، مقدمة كتاب مقتل الحسين: ص5.
[41] اُنظر: كاشف الغطاء، محمد حسين، المجالس الحسينية، مخطوطة تم تحقيقها على يد: أحمد بن علي بن مجيد الحلي سنة 1428هـ/ 2007م، ولم يتم طبعها لحد الآن وهي موجودة في مكتبة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء: ورقة 26ـ64.
ومن الجدير بالملاحظة أن المحقق لم يذكر أن تلك المجالس قد تكون هي المقتل الكبير الذي ذكره الشيخ.
[42] اُنظر: كاشف الغطاء، محمد شريف، مقدمة كتاب مقتل الحسين: ص4ـ5.
[43] اُنظر: مخطوطة المجالس الحسينية: ورقة 26 ـ 64. كتاب مقتل الحسين: ص10ـ77.
[44] كاشف الغطاء، مقتل الحسين: ص38.
[45] الكرمي، ناصر، الإمام الحسين كما رأيت: ص396.
[46] اُنظر: كاشف الغطاء، مخطوطة المجالس الحسينية، ورقة: 1،3،4،8،12،13،32. كاشف الغطاء، مقتل الحسين: ص10، ص53.
[47] مقتل الحسين: ص62.
[48] المصدر السابق: ص68.
[49] مخطوطة المجالس الحسينية: ورقة64. مقتل الحسين: ص76.
[50] مخطوطة المجالس الحسينية: ورقة 64، هامش التحقيق: رقم221.
[51] عبيد، ظاهر جبار، التجديد والإصلاح في فكر الشيخ كاشف الغطاء، مجلة قضايا إسلامية، العدد 5: ص488 ـ489. هيدان، الفكر السياسي: ص117.
[52] اُنظر: هيدان، الفكر السياسي: ص117.
[53] كاشف الغطاء، محمد حسين، كتاب جنة المأوى، جمعه ورتبه وعلَّق عليه: العلامة السيد محمد علي القاضي الطباطبائي: ص139.
[54] كاشف الغطاء، الخطب: ص149.
[55] اُنظر: كاشف الغطاء، جنة المأوى: ص139.
[56] كان الشيخ مصلحاً صُلْباً، وقد ظهر ذلك في كثير من مواقفه التي تميزت بالصرامة والصبر على الصعوبات؛ وقد كان يرى أن الشجاعة لا تعني فقط الإقدام في الحروب، واقتحام نيران الوغى، بل إنها مَلَكَةٌ راسخة في النفس فطرية ومكتسبة، ومنها الانتصار للحق، وقول كلمته عند سلطان ظالم، وعدم الرضوخ أمام الباطل.. وما السكوت عن الظلم والقعود عن مقاومة الباطل إلا بفقد مَلَكَة الشجاعة، وهذا هو الداء المنتشر بين المسلمين. اُنظر: كاشف الغطاء، محمد حسين، الميثاق العربي الوطني: ص85.
[57] كاشف الغطاء، محمد حسين، الفردوس الأعلى، علق عليه: محمد علي القاضي الطباطبائي، صححه واهتم بنشره: السيد محمد حسين الطباطبائي: ص19.
[58] المصدر السابق: ص20ـ21.
[59] اُنظر: المصدر السابق: ص22.
[60] اُنظر: جنة المأوى، ص124ـ 125، ص138ـ 139، ص147، ص156ـ157.
[61] اُنظر: المصدر السابق: ص153ـ 154، ص162، ص246ـ247.
[62] اُنظر: المصدر السابق: ص132ـ135، ص136ـ137، ص140ـ 146.
[63] اُنظر: المصدر السابق: ص104ـ 106.
[64] المصدر السابق: ص118ـ 119.
[65] ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه: ج1، ص51. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص324.
[66] اُنظر: كاشف الغطاء، جنة المأوى: ص128ـ131.
[67] اُنظر: المصدر السابق: ص131.
[68] اُنظر: المصدر السابق: ص136ـ137.
[69] اُنظر: العقَّاد، عباس محمود، أبو الشهداء الحسين بن علي: ص77ـ88.
[70] اُنظر: كاشف الغطاء، جنة المأوى: ص147.
[71] اُنظر: المصدر السابق: ص148ـ152.
[72] كما في رؤية بُحيرا الراهب وحده للغمامة التي تُظلل النبي صلى الله عليه وآله. اُنظر: ابن إسحاق، محمد : ص74. الطباطبائي تعليقات على جنة المأوى: ص150، هامش2.
[73] اُنظر: كاشف الغطاء، جنة المأوى: ص156.
[74] اُنظر: المصدر السابق: ص162.
[75] اُنظر: المصدر السابق: ص133.
[76] الطباطبائي، تعليقات على جنة المأوى، ص162، هامش1.
[77] اُنظر: خالد، خالد محمد، أبناء الرسول في كربلاء: ص161.
[78] اُنظر: كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص2.
[79] تبيَّن ذلك للباحث من إجابة الشيخ على أحد الأسئلة الموجهة إليه والمنشورة في كتاب جنة المأوى: ص154ـ156؛ إذ يقول: «ومن هذا إقدام الإمام الحسين على الشهادة، مع علمه بأنه مقتول لا محالة، ولا شك أنهم سلام الله عليهم كانوا يعلمون بكل ذلك بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وحياً، ولكن يحتملون في أن يتطرَّق إليه البداء...».
[80] اُنظر: كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص7ـ34.
[81] الشيخ كاشف الغطاء: ص61.
[82] هيدان، الفكر السياسي: ص10.
[83] كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص3ـ7.
[84] المصدر السابق: ص8.
[85] المصدر السابق: ص10ـ11.
[86] اُنظر: المصدر السابق: ص11.
[87] حجر بن عدي الكندي المعروف بحجر الخير، وفد على النبي صلى الله عليه وآله فأسلم، وكان من فضلاء الصحابة وشهد حروب الإمام علي عليه السلام ، قُتل سنة 51هـ/ 671م، بعد أن اعترض على سياسة زياد بن أبيه في الكوفة، وتم إرساله إلى معاوية؛ ليُنفِّذ فيه القتل، مع سبعة من أصحابه ورغم أنها مأساة منكرة إلا أنها لم تُثر أكثر من النقد الكلامي ضد معاوية وأعوانه. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، جمل من أنساب الأشراف: ج5، ص265ـ266. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة في معرفة الصحابة: ج1، ص385ـ386. التميمي، ثورة الإمام الحسين: ص132ـ142.
[88] اُنظر: كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص12.
[89] المصدر السابق: ص12.
[90] اُنظر: المصدر السابق: ص13ـ14.
[91] اُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص380. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك: ج6، ص213.
[92] اُنظر: كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص14ـ15.
[93] اُنظر: كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص25.
[94] اُنظر: المصدر السابق: ص23.
[95] اُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص387.
[96] اُنر: المصدر السابق: ج3، ص384. واُنظر المناقشة الدقيقة لذلك: التميمي، ثورة الحسين: ص280ـ283.
[97] اُنظر: كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص17.
[98] اُنظر: المصدر السابق: ص17.
[99] من شيعة الامام علي عليه السلام ، ذهبت عينه اليسرى يوم الجمل، وضرب يوم صفين ضربتين على رأسه وحاجبيه فذهبت عينه الأُخرى، فكان لا يفارق المسجد الأعظم في الكوفة يصلي فيه ليلاً، ثم ينصرف. اُنظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك: ج6، ص249.
[100] الأنصاري الخزرجي، شهد مع الرسول صلى الله عليه وآله سبع عشرة غزوة، سكن الكوفة وابتنى بها داراً في كندة، شهد مع الإمام علي عليه السلام صفين، وهو معدود في أصحابه، توفّي في الكوفة سنة 68هـ/687م.
[101] كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص18.
[102] اُنظر: المصدر السابق: ص21. واُنظر ـ لصلب عبد الله بن عفيف الأزدي في السبخة ـ: الطبري، تاريخ الطبري: ج6، ص249ـ250.
[103] اُنظر: كاشف الغطاء، في السياسة الحسينية: ص23.
[104] اُنظر: المصدر السابق: ص20ـ21.
[105] اُنظر: المصدر السابق: ص30.
[106] اُنظر: كاشف الغطاء، السياسة والحكمة: ص91.
[107] كاشف الغطاء، في السياسة الحسينية: ص32.
[108] اُنظر: المصدر السابق: ص33.
[109] كاشف الغطاء، محاورة الإمام كاشف الغطاء مع السفيرين البريطاني والأمريكي في بغداد: ص57.
[110] اُنظر: كاشف الغطاء، نبذة من السياسة الحسينية: ص25، ص29، ص33.
[111] اُنظر: المصدر السابق: ص12، ص27، ص29.
[112] اُنظر: المصدر السابق: ص9، ص10، ص13، ص14، ص16، ص18، ص21، ص24، ص29، ص32.
[113] اُنظر: المصدر السابق: ص27، ص28.
[114] اُنظر: المصدر السابق: ص12، ص18، ص20ـ21.
[115] اُنظر: هيدان، الفكر السياسي: ص19.
[116] السلامي، عمار عبد الأمير، شعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ـ دراسة موضوعية فنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الكوفة: ص40.
[117] اُنظر: كاشف الغطاء، مقتل الحسين عليه السلام : ص80 ـ 128.
[118] اُنظر: السلامي، شعر الشيخ محمد حسين: ص40.
[119] اُنظر: المصدر السابق: ص40 ـ 41.
[120] كاشف الغطاء، مقتل الحسين عليه السلام : ص87.
[121] المصدر السابق: ص83. واُنظر: ص88 ـ 89.
[122] المصدر السابق: ص83.
[123] المصدر السابق: ص83.
[124] المصدر السابق: ص90.
[125] المصدر السابق: ص84. واُنظر: ص91ـ120.
[126] المصدر السابق: ص97. واُنظر: ص92، ص98، ص107، ص108.
[127] المصدر السابق: ص84، ص92.
[128] المصدر السابق: ص99. واُنظر: ص100ـ 101.
[129] المصدر السابق: ص114.
[130] المصدر السابق: ص119.
[131] المصدر السابق: ص105ـ106.
[132] المصدر السابق: ص116ـ 117.
[133] اُنظر: السلامي، شعر الشيخ محمد حسين: ص46.
اكثر قراءة