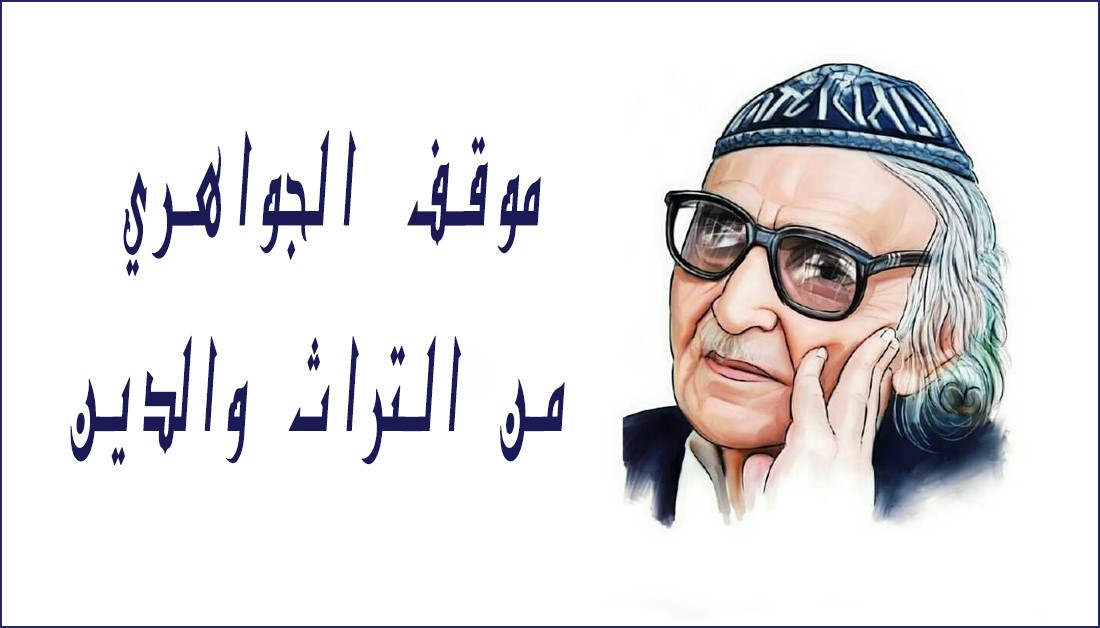المقالات

القسم العام
موقف الجواهري من التراث والدين
لا يخفى أن للجواهري الشاعر الكبير حضوراً في مشهد الحياة العربية في القرن العشرين، وكان له موقف من التراث، الأمر الذي دفعه إلى أن يكون في مصاف عظماء الشعراء، فكان لنا عبر هذه المحاضرة، أنْ نبيّن موقفه من التراث وبالتلازم مع ذلك نسلط الضوء على موقفه من المعاصرة والأساليب والأجناس الأدبية.
المسؤولية التي يتحملها الشاعر تجاه مجتمعه الذي يؤدّي رسالته له، يلخصها الجواهري بالقول: (إن الشاعر جزءٌ من مجتمعِهِ)، وهذه الرؤيةُ تأتَّتْ لهُ من كونهِ وُلِدَ في مجتمعٍ محافظٍ على قيمِهِ، وهويَّتِهِ الإسلامية والقوميَّة، فضلاً عن تأثُّرِهِ بشعراء كان لهم الحضور الواسع في الميدانين: الاجتماعي والأدبي، مثل الشاعر السيد (محمد سعيد الحبُّوبي) الذي كان قويَّ الصَّلة بأسرة شاعرنا الجواهري، ولا يُنكَرُ مالَهُ من شاعريَّةٍ طبَّقتْ آثارُها على مجملِ الحركة الأدبيَّة في العراق آنذاك، ومن حضورٍ لا أقلَّ منه شهرةً في الميدان الاجتماعي والديني بين الناس، والجهاد ضدَّ المستعمرين الغزاة إلى آخر حياتِهِ. ومن القضايا التي تحدَّث عنها الجواهري، وناقش بعضها الآخر في مقدِّمته لمختاراته – (الجمهرة)- بجزأيها الأوَّل، والثاني، هي تحوُّل الشعر الجاهلي في عهدي صدر الإسلام، والأموي ومناقشته لرأي أدونيس في مختاراته (ديوان الشعر العربي)، ورأي الدكتور (طه حسين) في الشعر الجاهلي، وقد جعل مناقشته لهما تحت عنوان (الشعر الجاهلي بين مطرقتي الفردية والنكران)، و(الفردية) هي ما وصم بها آراء أدونيس التي تلخَّصت في أنَّ الشعر يكتسب قيمته الأخيرة من داخله، فيما ذهبت آراء الدكتور (طه حسين) إلى (نُكران) وجود الشعر الجاهلي، وهذا من المؤاخذات التي رصدها الجواهريُّ على (طه حسين). حيث نقد الطريقة التي جعل (طه حسين) بموجبها يقفز بيُسرٍ وسهولة على قوانين الأصالة والإبداع التي تتطلَّبها موازين الشعر العربي إلى أسلوب منفلتٍ يتناول الشعر من دون ضوابط تأخذ بحسبانها واقع المجتمعات العربية وازدواجيَّة المعايير، فبينا هو يسخرُ من النهج القديم في دراسة الأدب العربي، ولاسيَّما في جاهليَّته، وسائر العصور المتعاقبة حتَّى يومنا هذا، فإنَّه في جانبٍ آخر يُغالي فيما يريده لدارسي الأدب العربي، وذلك فيما يُمليه عليهم من شروطٍ تعجيزيَّةٍ، كالإلمام الدقيق بالتاريخ القديم والحديث، والمعرفة باللغات الأجنبيَّة بما فيها اللغة اللاتينيَّة بوصفها المدخل إلى حضارة الإغريق، وآدابهم، وشعرائهم، وأساطيرهم.
ومن مؤاخذته على مخالفته لمنهجيَّة البحث التي دعا إليها كثيراً في مؤلَّفاته، ولاسيَّما في كتابه (الشعر الجاهلي)، وأعاد الكرَّةَ عليها في (الأدب الجاهلي)، وهي التحرُّر العقلاني في اتِّخاذ موقفٍ جريءٍ من كُلِّ ما في التاريخ العربي بصورة عامَّة، والأدب العربي بصورةٍ خاصَّة، وذلك عن طريق اتِّخاذ الشكِّ (الديكارتي) ذريعةً للوصول إلى اليقين، وإذا به يتَّخذُ الشكَّ منطلقًا وغايةً، وهذا ما يُفضي به إلى التحاملُ على كُلِّ شيوخ العلم، والأدب، والرواية، والحديث، والشعر من ذوي أصولٍ غير عربيَّةٍ ممَّن ساهموا في خدمة الحضارة الإسلامية في كُلِّ هذه المجالات، فيُشكِّكُ في أمانة هؤلاء العلماء، والرواة، وفي صدق ولائهم، وكذلك يتَّهمهم بالدسِّ على الإسلام، وبرواية الشعر، أو الأخبار من دون سندٍ يُذكر، أو حجَّةٍ مُقنعة.
ولا يفهم أنَّ الجواهري حين آخذَ الدكتور (طه حسين) على تلك النظرة المُشكِّكة، أنَّه ينكرها بالمرَّة، فهو أيضًا ممن يؤمنُ بها كطريقة يتمُّ الوصول بها إلى الحقيقة، بل أكثر من ذلك، فقد عدَّها حقيقةً لا يمكنُ التغاضي عنها، وذلك مستفادٌ من قوله في قصيدة (نزوات): حقيقةُ الأمر عندي الشكُّ والإرْتيابُ.
أو بقوله من قصيدة (آمنت بالحسين):
وجازَ بيَ الشكُّ فيما معَ «الـــــجدودِ» إلى الشكِّ فيما معي
وإنَّما أنكرَ الإسراف، والتمادي في الأخذ بها، وهذا ما جعله يُشخِّص موقف (طه حسين) بأنَّهُ موقفٌ تسوده الأفكار الجاهزة، والأهواء بقدر ما يسوده الارتباك، والتعثُّرُ، والهلهلةُ تبعًا لذلك.
ومن مؤاخذته أيضاً على طه حسين روح العصبيَّة التي سادت خطابه النقدي، وذلك حين جعل شيوخ الشعر واللغة من (الموالي)، بل تعدَّى ذلك إلى نفي العروبة عن أعظم الشعراء العرب كالطائيين، والمتنبي، وإلصاق تهمة (العُجمة) بهؤلاء الشعراء - بحسب الجواهري - أقربُ إلى روح الجاهليَّة منها إلى الإسلام الذي ينتمي إليه طه حسين، فضلاً عن اتهامه شعراء آخرين بالولاء للفرس.
ونُشيرُ إلى أنَّ الجواهري في مناقشته الدكتور (طه حسين) بشأن دعواه بنسبة معلَّقة امرئ القيس إلى عمر بن أبي ربيعة، يزعم أنَّه أولى من الدكتور طه بتمييز هذا الشعر، أو ذاك من غيرهما، وبالحكم على مستواهما، وعلى مضامينهما، وعلى مزاج صاحبيهما، ويُقوِّي زعمه هذا، بما كان يراه (طه حسين) من أنَّه في المجال الشعري، ليس هو في المجال النثري والكتابي. وهكذا رفض الجواهري جملةً من شكوك الدكتور (طه حسين) حول وجود شعراء آخرين عاشوا في العصر الجاهلي، مختتمًا تلك المناقشات لآراء (طه حسين) المبثوثة في كتاب (في الأدب الجاهلي)، بأنَّ أقوى ما لدى (طه حسين) من حججٍ، مأخوذٌ من كتاب طبقات فحول الشعراء، لابن سلاَّم الجمحي، وهي حججٌ غير مقنعة؛ لأنَّ الرواة الذين اتُّهموا بالنَّحل والكذب لم يكونوا كذلك، ويؤكِّدُ الجواهري زعمه بما ورد في كتاب (مصادر الشعر الجاهلي) للدكتور (ناصر الدين الأسد)، وكذلك نقدُهُ للطريقة التي كان يوظِّفُ فيها الدكتور (طه حسين) للنصوص الواردة في كتاب ابن سلاَّم، وبحسب قوله: (فهو يأخذُ من النص ما ينفعه، ويقوِّي حجَّته - فيما يُخيَّلُ إليه- ويحذفُ منه ما يُضعِفُ من تلك الحجَّة. وهذا وحده ما يطعنُ في أحكامه طعنًا جارحًا).
ولما كانت مهمتُنا في هذا المبحث استعراضَ موقفِ الجواهري من التقليد والتجديد، لا بدَّ لنا من تبيانِ مسيرتِهِ الفنيَّةِ ومدى خروجِهِ عن التقليد في الشعر، فقد بدء كغيرهِ من الشعراء الذين يبدؤون بتقليد من سبقَهُم، وهذا ما أشار إليه في مجموعته الشعرية الأولى (حلبة الأدب)، بقوله: (لقد خُلِقتُ ولِعًا منذ الصغر بجمع شواردِ الأدباء وأوابدِ الشعراء بتتبع آثارهم النفيسة، وكنت قد اخترتُ لي خطَّةً لسلوكي في عالم الأدب لم أحِدْ، ولن أحيدَ عنها... تلك أني ما رأيت مجرَّ قلمٍ لأديب كبير إلا تطفَّلتُ عليه، وسرت النهجَ الذي قصده، والغايةَ التي اطَّلبها، وكنت أجهد كل الطاقة، وأبذل غاية المقدور لأن أكون منه بحيث يرى نفسه كأني أتطلع إلى خفايا أسراره الشعرية الدفينة، وما مجموعي هذا إلا صورةٌ من تلك الرغبة، ونموذجٌ من هاتيك الدعوى)، فكان بهذه الرؤية تقليدياً في موضوعاته الشعرية التي لم تخرج عن (الوطنيات والوصفيات) بحسب نعته لها، فصياغته الشعرية لم تخرج عن احتذاء الموروث في الصور والتراكيب والأوزان والقوافي، والتعامل معه كشيءٍ مقدس، فكان من الطبيعي أن تشيع فيه التراكيب التقليدية الشائعة في الشعر العربي القديم لتستكمل القصيدة كل عناصرها الكلاسيكية، وحتى في مواقفه مع شعراء عصره، لم تخرج عن حدود النظرة التقليدية، بخلاف تلك النظرة التي رآهم بها في أربعينات القرن العشرين؛ إذ تحوَّل الشاعر إلى ذات واعية تتمثل في وجدان الشعوب ومعاناتهم، واقترن بهذا التحول نضجٌ في صياغته الشعرية، فقد وُفِّق في توظيف مخزونه الثقافي الذي تمظهر في نسغ القصيدة، فتشكَّلت الصورُ القديمة من جديد إلى جانب الصور التي يخلقها الشاعر باستخدامه قدراته الخيالية الخاصة، فكانت المعلقات ذات النفس البطولي، التي استوحى فيها أفكاراً، وقيماً بطولية، تراثية ومعاصرة، فردية وجماعية، مستلهماً في كلِّ ذلك (طاقات العربية الكلاسيكية وتفجيرها في رؤية أعمق، ومعاناة أشد توتراً لمشكلات الواقع)، فضلاً عن تنويعه في بنية القصيدة إلى أشكال (تبدو وكأنها خلقٌ جديد لخفاء العناصر الباقية فيها من التجارب الأصل التي تطورت عنها).
وقد دخل أسلوب الشاعر تطورٌ جديد عما كان عليه سابقاً تمثَّل في بنائه للصورة، ونسيجه اللغوي نتيجةً للتأثر بموجات الحداثة، المتمثلة بالغموض والإيحاء التي وصلت البلاد العربية من الغرب، محاولاً إعطاء قصيدته التقليديَّة ذات الشطرين سماتٍ حداثويَّة، وذلك من خلال المخالفات، والمغالطات الشكليَّة التي يسعى فيها إلى مواكبة شعراء المهجر بكتابة الموشح، أو مقاربة المغاربة في تفتيتهم الشكل الموروث للقصيدة، وهذا يُقلِّلُ من رتابة الشكل التقليدي في توزيع الكلام الشعري على شطرين، ومن خلال التلاعب في علامات الترقيم، كالفارزة، والنقاط التي تسمح بانقطاع الصوت للحظات الفصل، وفي مساحة البياض الطباعي، وما يؤكد نزعته الموسيقية المتكئة على إحساسه الوجداني بموضوعه، وتوظيفه للإيقاع الداخلي عبر ظهور التقسيم أو التناظر داخل النص.
وبعد هذه الإضاءة التي نلمس فيها مدى تجاوب الجواهري مع متغيرات العصر، وانحرافه عن التقليد الذي حفل به منجزه الشعري في بداية مسيرته الشعرية، نسلط الضوء على منجزه الشعري والنثري، بغية تبيان أهم آرائه النقدية التي وردت بشأن التقليد والتجديد، ولما كان الشاعر يُنظر إليه بوصفه أحد أنصار القديم، أردنا أن نفحص هذه النظرة من خلال خطابه، وذلك لأنَّ القديم - وكذلك الجديد - من المفاهيم الكُلِّية المُشكِّكة بحسب اصطلاح المناطقة، لا يمكن أن تتفق صفاته عند الجميع، فما يراه أحدهم قديماً قد يراه الآخر جديداً، ويزداد الأمر لبساً حينما يُصرِّح شاعرنا الجواهري بأنَّ القديم هو الجديد، وذلك في قوله من قصيدة (فتيان الخليج):
وقائلةٍ: أما لكِ من جديدٍ؟ أقولُ لها: القديمُ هو الجديدُ
فهل كل قديمٍ جديدٌ عند الشاعر؟ أم أنَّ هناك أسساً ومعاييرَ، يرى بموجبها القديم جديداً، والجديد قديماً، وهذا ما يستدعينا أن نُديمَ النظَرَ في ما رآه الشاعر بنفسه، محاولين الابتعاد عن مناقشة رأيه، أو إبداء موقفنا منه، إلا بالقدر الذي يسمح نطاق البحث لنا، وذلك فيما يأتي:
أولا: الموقف من القديم:
لما كان التراث يشمل كل القيم الدينية والحضارية والتاريخية، سواء منها المكتوبة أو المتوارثة منذ أقدم الأزمنة، أي كل ما خلفه الأسلاف من أدب وفكر وكذلك من عادات وتقاليد وقيم سواء منها المكتوب أو المنقول، فقد تحدَّدت أهمية اللغة بأنها الوساطة التي يتلقى بها الشاعر تلك المضامين المتعددة. وموقف الشاعر من حيث كونه مقلداً، أو مجدداً، إنما يتحدد في ضوء علاقته بالماضي ونظام اللغة - بكل مستوياتها الصوتية والدلالية والنحوية والبلاغية - أو بالحاضر ومتغيراته التي تطرأ عليها، فاللغة تكون أقوى ما يربط الشاعر بالماضي؛ لأنه لا يستطيع الإفلات من نظامها، أو تحطيمها كلياً، وهذا ما حاول الجواهري الحفاظ عليه على طول مسيرته الشعرية، فاللغة عنده لا تنتمي لعصر دون آخر، وإنما هي جزءٌ لا يتجزأ من مكونات لغة الشاعر الذي يقهر الزمن، ويجعلها مرنةً لتكون أكثر طواعية وإيحاءً، فلذا كان أهلاً بوصف الدكتور (طه حسين) له بـ(البقية الباقية من التراث الأدبي العربي الصحيح). وقد عبَّر الجواهري عن تجربة الشاعر وصلتها بالتراث فقال: ((إنَّ التراث أصل الأمة وشريانها المانحُ دمَ القدرة والتجدد، وهو ركيزة اللغة. [فـ] اللغة العربية لغة تراث وسحر وإعجاز، ومن لا لغة له لا تراث له والعكس صحيح، يجب أن تكون استنادات الشعر العربي على تراثه جوهرية؛ لأنَّ المظهر أصل الجوهر والتعبير عن العصر مسألةٌ زمنية).
لقد استفاد الجواهري من الموروث القديم بأمثلته العالية، ولكن ليس بصيغة التقليد والمعارضة التي كان عليها في مرحلته الأولى في نظم الشعر، بل بالتفاعل الحي معه ليضفي عليه شيئاً من صورة العصر ويتآزر معها لتعميق مضمون القصيدة، غير أنَّ ذلك يبقى حالة محدودة إن لم تكمله مواقف فكرية تحدد وجهة النظر إليه، فقد رأى أنَّ اللغة العربية (هي تراثنا الوحيد الذي نباهي به شتى اللغات والأمم)، وعليه يكون من الضروري أن يتعرَّفَ الأديبُ على هذه اللغة من مظانِّها الصحيحة من كتب التراث اللغوي والأدبي، ولاسيَّما تلك الكتب التي مازالت محتفظةً برونقها وديباجتها، فلا حاجة إذاً أن تكون ثمة قطيعة بيننا وبين التراث، لأنَّه إذا كان الكُتَّابُ المشهورون في العالم قد أفادوا من تراثهم اللغوي متخذين منه أحسن القوالب لأفكارهم وإحساساتهم، فلا محلَّ إذاً للتنكُّرُ لهذه النماذج التراثية من لدن بعض الأدباء العرب إذا قصدوا احتذاء النموذج الغربي في التطور والتجديد. ويرفض الجواهري على أساس هذه النظرة، جُلَّ الأنماط الكتابية الموجودة في عالم الأدب اليوم، فهي لا تعدو أن تكون عنده على حالين من الجمود (لا يتجاوز الخشونة ..أو..الإسفاف، وما بين هذين نمط ليس بالقوي المتين ولا بالسهل المقنع)، ولا يتم القضاء على هذا الجمود، ومواكبة الجديد إلا بالرجوع إلى الأسلوب الصحيح في بلاغة اللغة العربية، مبيِّناً أنَّه الأسلوب الصحيح (الذي لم تشنه الصناعة اللفظية بإلزاماتها الغير اللازمة...التي خرجت بالآداب العربية عن كل مزاياها إلى عالم جمل وألفاظ اصطناعية.. وإلى أسجاع متكلفة لم تحلم بها هذه اللغة الحرة التي تنزلت كرذاذ المطر تصيب مواقعها من دون تنسيق ولا تعمد)، فقد عاب تلك الصناعة اللفظية الجوفاء التي ابتعدت عن المضمون، التي كُرِّس لها جهدٌ غير مشكور قام به ما وصفهم بـ (هياكل الأدب الاصطناعي) في قرون الانحطاط السياسي والاجتماعي، مثل ابن سناء الملك (ت608هـ)، وابن نباتة المصري (ت768هـ)، وصفي الدين الحلي (ت750هـ) وغيرهم.
ولما كان التطور ومواكبة الجديد لا يقوم عند الجواهري إلا بالرجوع إلى آثار السلف الصحيحة، والممثلة بشكلها ومضمونها عن الروح العربية الأصيلة؛ لأنها (كل ما نملكه اليوم من عِدَّةٍ نتقي بها التفسخ الكتابي من جهة وننمي بها هذه الملكات الضعيفة التي أصبحت بعيدة عن أصولها بعدها من غيرها من اللغات الأجنبية)، فهو من جانب آخر يحيل أسباب الضحالة في الأسلوب الكتابي الشائع آنذاك، إلى ما تركته العصور المظلمة من سوءات فكرية واجتماعية، فالمتوقع هو أن تتفشى هذه السلبيات في ((أمة تعاقبت عليها كل هذه الأدوار التاريخية التي خرجت منها على أشد ما يكون عليه المحكومون المغلوبون من فقدان الصفات اللازمة لحفظ كيانها ومقوماتها الأدبية)، ولكن لا يعني ذلك أن نقف إزاءها مستسلمين، بل لابدَّ من النهوض بالمستوى الأدبي، وذلك بالرجوع إلى تلك الآثار الصحيحة، وإن كانت على درجة من العمق، وصعوبة التزود منها، لكنها على أي حال تقي صاحبها الكثير من العثرات الفاضحة في عالم الأدب، ولذا رفض أن تكون لغة الجرائد زاداً يتأدب عليها الناشئة من الأدباء، لأنها لا تساعد على إيجاد ملكة قوية، وكذلك رفض أن تكون الكتب الأدبية الركيكة بأسلوبها، والمملوءة بمبتذل الأشعار والمواضيع، ملاذًا يتخلص بها هؤلاء من دقة الكتب النقدية المُعدَّة أصلاً لا يمكن الاستغناء عنها في الأدب والنقد، ومن رصانة معاني الفحول من الشعراء؛ لأنها ليست الضمان على تغذية ملكات هؤلاء وإعدادها لتفهم مناحي التفكير وتطوره.
ويصل إلى الموقف ذاته حينما ينظر إلى الماضي ليحمله عبأ انقطاعنا الحضاري، وذلك حينما يكون التطلُّعُ إلى الجديد غيرَ محدَّدٍ بضوابط، وأصولٍ معيَّنةٍ يمكن الاطمئنان إليها، أو بعبارة أخرى حين يكون التطلُّعُ إلى الجديد والمناداة به نقيضاً للاهتمام بالماضي، فانشغالُنا بالرديء من القديم وإصغاؤنا له، هو السبب في تقديرنا السيِّئ للجديد، وهذا ما أشار إليه في قطعةٍ له:
قلت للمُعجَبينَ بابنِ العميدِ ومُساماتهِ لعبدِ الحميدِ
إنَّ هذا وذاك عبادُ أصنامٍ ومأساةُ سيّدٍ ومسودِ
..قد شَغَلْنا أفكارَنا بقديمٍ ونَسِينا تقديرَ جيلٍ جديدِ
إنَّ خيرَ الآدابِ ما أنهض الشعــبَ، وما فكَّ من إسارِ قيودِ
ومن خلال ما تقدم يتَّضحُ لنا ما أراده الجواهري في تعامله مع التراث الشعري، ورؤيته للمعاصر منه، إذ لم يرد الخضوع إلى زمن التراث، بل التأثر بجودته، وهذا ما يعني إلغاءه التعارض بين القديم والمعاصر.
وإذا كنا فيما سبق قد تعرضنا لآراء الجواهري في الشعراء القدماء من حيث احتذاء النموذج المثالي في شخصية الشاعر، فهو كذلك قد أفصح بأنَّ بعض شعراء تلك العصور لم يكونوا على مستوىً من الرقي بأسلوبهم في بناء الألفاظ، ورصف المعاني، وطريقة استعراضها، بخلاف آخرين كان لهم فضل السبق في ابتكار الصور وتوليد المعاني الطريفة.
ثانيا: الموقف من الجديد:
لقد مثَّل الجواهري صوت المناصرين للجديد في عصره حين وقف معارضاً لاتجاه الشعراء الشيوخ في مدينته المحافظة على تقاليدها الدينية والاجتماعية والأدبية، وذلك بتأييده للشعراء الشباب الذين يُعَدُّونَ من جيله آنذاك، في قصيدة (درس الشباب، أو بلدتي والانقلاب) إذ خاطب فيها مدينته - على نحو المجاز العقلي - أي: أهل مدينته، بقوله:
إنزعي يا بلدتي ما رثَّ من هذي الثيابِ
وإذا خِفتِ عَراءً فسيكسوك صحابي
وإذ يخاطب فيها هؤلاء الشعراء الذين تمرَّدوا بخروجهم على الموضوعات التقليدية التي حافظ شيوخ الشعراء المحافظين على استمرارها، فلا يفوته أن يحثُّهم على المُضيِّ بهذا الطريق، ويملي عليهم تعاليمه الحكيمة في كيفية النظم قائلاً:
يا بني العشرين في أعمالكم فصلُ الخِطابِ
...إلزَموا خيرَ صِحابٍ إقرأوا خيرَ كتابِ
أطلِعوا للشعر شمساً لا تُبقِّي من ضبابِ
أترُكوا كلَّ قديمٍ منه يسعى في تَبابِ
وقد حدَّد الجواهري بداية الصراع بين أنصار القديم والجديد في الشعر، بعد الحرب العالمية الأولى، منيطًا أسبابَهُ بالصراع العالمي الدائر آنذاك بين القوى الدولية الكبرى، وبالمتغيرات الثقافية التي أخذت بالانتشار في سائر دول العالم إبَّان تلك الحقبة، جاعلاً إيَّاه على مرحلتين:
الأولى: مرحلة الشيوخ الأوائل، ومن شعرائها: السيد الحبوبي، والسيد حيدر الحلي (ت1304هـ)، وجواد الشبيبي (ت1363هـ)، وعبد الحسين الجواهري (والد الشاعر)، وجعفر الحلي (ت1313هـ)، وقد اتَّسم صراعهم بالترفع عن الإسفاف، أو التشهير.
الأخرى: وفيها ظهر الصراع جلِيَّاً بين تيارين، الأول هم المجددون، مثل الشيخ محمد رضا الشبيبي، وعلي الشرقي، وعبد العزيز الجواهري، وصالح الجعفري، والثاني: هم المقلدون، ومثل هذا التيار الشيخ مهدي الحجار، وكاظم السوداني، وقد انضم الجواهري إلى تيار المجددين، معجباً أيَّما إعجاب بالسيد الحبوبي، مأخوذاً بسحر شخصيته، ورقة شاعريته.
ومن أهمِّ الأفكار التي انطلق منها الجواهري في نقده للتقليد في الأدب، هو ما تنبَّه إليه من دعوة للتجديد من لدن بعض الأدباء، وهم في حقيقة الأمر إنما يقلِّدون آداب الأمم الأخرى من دون وعيٍ منهم؛ إذ يرى أنَّ التجديد يجب أن يكون منبثقاً من صميم تراث الأمة وآدابها، فيمثِّلُ هويَّتها القوميَّة، وطبيعة نسيجها الحضاري، وإلا ما فائدة أن يكون التجديدُ صدىً لآثار الأمم الأخرى، ومن هذه الفكرة كانت له مواقف نقدية حسم فيها القول بأنَّ مثل هذه الدعاوى لا تمثل التجديد بقدر ما تمثل التقليد بلبوس الدعوة إلى التجديد في كتابة الشعر، فضلاً عن نقده، ومن ذلك مناهضته لدعوة (أمين الريحاني) في كتابة الشعر المنثور، إذ أفصح عن أساسين رفض بموجبهما هذا اللون الشعري، وهما: خلو الشعر المنثور من عنصري الوزن والقافية، والثاني: كونه تقليداً للشعر الغربي، ثم يرى أنَّ التجديد في الشعر العربي يمكنُ أن يتحقق عن طريق استخراج الأوزان الجديدة منه، ويرى في الموشحات الأندلسية خير بديل للشعر المجرَّد من الوزن والقافية، فقد أعلن أنَّه يدين بالتقليد، ولكنَّه مع ذلك يرى أنَّ تقليده ليس كالآخرين ممَّن ضاقت بهم (خطة الأدب العربي الوسيعة...[فـ]عوضاً من أن يستخرجوا من أوزانه وأعاريضه، أوزاناً وأعاريض أخرى ليكون لهم أيادي خالدة عليه، فقد نزلوا كلاًّ على الأدب الإفرنجي)، ولهذا وجدناه ينعى على الريحاني وأشياعه شعرهم المنثور، وسعيهم في تقليد الشعر الغربي، ونقله إلى اللغة العربية، إذ قال: (..خير من هذا الشعر المنثور الغربي الفاقد لرنَّة الشعر الموسيقية التي تنزل بها القافية على أعماق القلب بلا إذن، الموشَّحاتُ الأندلسيةُ المشعَّبةُ الفنون، الكثيرةُ اللطف والرونق، وخيرٌ لناقلها إلى العرب (أمين الريحاني) أن يكون ثاني "إبن باجة [ت533هـ]" وابن زهر [ت595هـ]، وابن الخطيب [ت776هـ]، من أن يكون ثاني (فلان) الإفرنسي والأمريكاني، وهو العربيُّ القح)، ويُصرُّ الجواهري على رفضه للشعر المنثور منتصراً لجلِّ الحركات التجديديَّة المستمدَّة من التراث العربي، ثمَّ ينتهي في مقاله إلى تقديم بديله عن الشعر المنثور، وهو موشَّح من نظمه تحت عنوان (وشاحٌ من الورد) وفيه يقول:
يغزل للفجرِ بيضَ الخيوطِ
والصبحُ إذ يسري مطالَع البِشرِ على النواحي
ونلاحظ أنَّ الجواهري قد ربأَ بنفسه عن المماحكات الشخصية إلى مناقشة القضايا العلمية الجوهرية، خلافاً للنقاد المتقدمين عليه فإنَّهم قد ركَّزوا في نقدهم على الريحاني نفسه، فراحوا يجردونه من كل فضل، وكذلك نلمس مثل هذه المناقشة الهادئة في موقفه مع الأديب (أحمد حامد الصرَّاف) الذي وصم شعر الحبُّوبي بالجمود، إذ أبان أنَّه يوافقه في أنَّ الشاعر لم يوجد في شعره ( أثر الشعر الغربي على النفوس، وأنَّه لا يبلغ ولا بعض ما يبلغه ذاك من التعبير عن آلام الناس...[ولكن] أن تريد من عراقي نجفي وُجِدَ في عصرٍ مظلمٍ قاتمٍ ما تريده من ابن (القرن العشرين) في أوربا فذلك ظلمٌ صُراح)، وعليه فقد ناشده في أن يكون أكثر إنصافاً للحبُّوبي، وذلك بمقارنة مستواه الفني الذي بلغه في شعره، بشعر الآخرين من أدباء العرب.
وقد يصعِّدُ شاعرنا في خطابه النقدي فيما بعد هذه المدَّة، وأعني بذلك ما كان قد سجَّله من نقد إزاء شاعرَي العراق المشهورين آنذاك على جميع شعرائه: الرصافي والزهاوي، الذَين عُدَّا من الشعراء العصريين، فقد رآهما قد أخذا شهرةً في الأدب العراقي لا تتناسب وآثارهما الأدبية، ولا تستحق أشعارهما إلا جزءًا قليلا مما يتمتعان به من مكانةٍ هي بغيرهم من الشعراء الشباب أجدر؛ لأنهم أرقى ملكةً وأمتن أسلوباً وأرق عاطفة منهما، فهم أولى بالزعامة الأدبية منهما، ويرى أنّ ثمة ظروف رجعية ساعدت على اشتهارهما، وإلا فهما يعيشان على حساب العصور المظلمة، ويخرج بالقول: (من الحِطَّةِ للأدب العربي أن تضيع نخبة ممتازة من الشعراء النوابغ قديرة على تمثيل النهضة الأدبية بكل خواصها وميزاتها أبلغ تمثيل واضحة، وقديرة تضيع لمجرد وجود نفر من الشعراء (المتقاعدين) من يحتكرون شهرة واسعة).
فهو يضع التجديد ضمن إطار شامل لتطور مجالات الإبداع، التي لا يجعلها رهناً بتطور وعي مبدعها، بل بتطور المجتمع في جوانبه المختلفة، وذلك بقوله: (أنا من المؤمنين بضرورة تطور الفن، وسيتطوَّر عندما يتطوَّرُ الرسَّام والنحَّات، وعندما يتطور ابن الشارع)، فالتطوَّرُ الذي يصيب القصيدة هو نتيجةٌ طبيعية لتطور مفاهيم العصر الذي يعيش الشاعر متغيَّراته، فالعصر بحسب قوله: (يتطور كثيراً وبأسرع مما نلحق به حتى على مستوى الشعر)، ولكن لا يسوِّغ ذلك أن تكون هناك طفرة يقفز إليها الشاعر في تغيير مسار القصيدة مبنىً ومعنىً، كما لا يُسوَّغ الركضُ لمن لا يعرف المشي، هذا على الرغم من إدراكه بأنَّ (النمط الكلاسيكي.. بلغ آخر ما يمكنه أن يبلغه، والصراع الآن في تجديد الشكل وعلاقته بالمضمون).
وعلى أساس تلك الرؤية كان للجواهري موقفٌ ذو شِقَّين مع تيار شعر التفعيلة، أو كما يُسمى بالشعر الحر، فالشِقِّ الأول تمثَّل بنقد الشعراء الذين وجدوا في الشعر الحر متنفَّساً لهم؛ لعجزهم عن مجاراة قصيدة الشطرين، فلم يظفروا بشيء من التجديد سوى الإساءة إلى اللغة، وهذه القيود التي ضاقوا بها ذرعًا، يرى الجواهري أنَّ وجودها لإضفاء الجمال الفني على القصيدة متمثلاً بالموسيقى، كما يضفي التزيُّن للفتاة جمالاً، وهذا ما أفصح عنه بقوله:
نَجَوا بزعمِهُمُ من أسْرِ قافيةٍ والشِعْرُ لولا إسارٌ نثرةٌ قِدَدُ
إنَّ الجمالَ «إسارٌ» عزَّ مُطَّلَبَاً هل يُحزِنَ الغِيدَ أن قد أسْرف الغَيَدُ
أمَّا الشِقِّ الثاني، فقد تمثَّل بموقفه المعجب - إلى حدٍّ ما - بأقطاب التيار الذين تمرَّسوا على نظم قصيدة الشطرين قبل كتابتهم لشعر التفعيلة (الحر). ونقول إلى حدٍّ ما؛ لأنَّه على الرغم من تمكن هؤلاء في كتابة الشكل التقليدي للقصيدة، لا يرى أنَّ الوقت قد حان لهذا التغيير، لأنَّه يجد أنَّ جمهور شعر الشطرين لا يزال موجوداً، فضلاً عن إيمانه المطلق بقدرة قصيدة الشطرين على استيعاب كل فكرة جديدة، وإذا طرأ عليها تغيير بحسب متغيرات المرحلة الزمنية والحضارية، فليكن (تنامياً على النمط الذي صار إليه الموشح، ثم منه إلى نمطٍ آخر)، والموشح بحسب رأيه - وهو رأي بعض النقاد - إنما جاء استجابةً لتطور واقع المجتمع، فلذا تبدَّل الأسلوب في شكل القصيدة تبعاً لهذا التغيُّر. وبحسب هذه الرؤى التي ينطلق منها الجواهري في تقييمه للشعر الحر، يرى أنَّ هذه الحركة (لن تسدَّ الفراغ، وذلك لعدم بلورتها...ومقياسنا في ذلك أنَّ الشعر الحر لم يدخل البيوت بعد، ولم يُستشهد به. بمعنى أنَّه لم يتخذ له بعد مكانة الشعر [أي قصيدة الشطرين]).
ولما كان الجواهري مؤمناً بالتطور في كلِّ مفاصل الحياة، فهو لا يستبعد أن يكون هناك تطور في شكل القصيدة (بحيث يجمع بين أصالة الشعر العربي المألوف وبين تطوير القوافي أو تطوير المقاطع الشعرية...وقد لا يخرج -حتى ولو تطور-عن بحور الشعر المألوفة لأنها واسعة بمرور الزمن وكافية)، وعلى هذا التأسيس لا يعد ما قامت به حركة الشعر الحر، تطوراً لكونه معالجة فردية، فهو (ليس مجرَّد معالجة فردية بقدر ما هو تطور عام، تطور مجتمع، والحقيقة إننا لم نتطور منذ زمن طويل)، وكذلك يرهن التطور بمقدرة الشاعر على تطويع الفكرة بأي نغمٍ وبأي شكل من دون فرضها مسبقاً في شكل يقترحه لها، وهذا ما يقطع الطريق أمام مروجي البضاعة الكاسدة المُسمَّاة شعراً بحجَّة مسايرتهم متطلبات العصر، وهذا ما نادى به سبيلاً ينطلق من خلاله الشاعر المبدع، وذلك في قوله من قصيدة (يا ابن الفراتين):
لا تقترحْ جنسَ مولود وصورتَه وخلِّها حُرَّةً تأتي بما تلِدُ
ومن الجدير ذكره أنَّ أهم شاعرٍ نال إعجاب الجواهري في مضمار كتابته شعر التفعيلة، هو بدر شاكر السياب؛ وذلك لتمكنه من نظم قصيدة الشطرين التقليديَّة، وهذا ما ينمُّ عن استيعابه للتراث العربي قبل انطلاقته لاستيعاب التراث العالمي، بقوله: (لماذا تميَّز السيَّاب...لأنَّ له أساساً في التراث العربي، ولذلك كان قادراً على التطوير...[و] من موقع رسوخه في التراث جدَّد في الرؤية والشكل).
أما النمط الذي ظهر بعد تيار شعر التفعيلة (الحر)، وهو ما يسمى بـ(قصيدة النثر)، الذي تطوَّر بأسلوبه عن الشعر المنثور، فمن الطبيعي أن يكون حرباً على أشياعه؛ لأنَّه يرى أنَّ أهمَّ خصيصتين للشعر تميِّزهُ عن النثر - وهي الوزن والقافية- قد فقدتا عند أدعياء هذا النمط، فما الفرق إذًا بينه وبين النثر؛ لأنَّ الشعر بحسب رأيه: (إذا بقي على الأفواه، فهو شعرٌ جيد ورائع، وهكذا أفهم الشعر القديم ...؛لأنَّ ما قالوه رددته الأفواه وحفظته، وهذا سر روعة شعرهم، وسر بقائه)، فضلاً عن اختلاف منطلقات هؤلاء الشعراء الفكرية والفنية عنه في وظيفة الشعر؛ إذ صار الشعر عندهم يقوم على حضور الأنا وغياب الآخر، ومن ثمَّ لم يسعَ الشاعر إلى أن يجعل قصيدته مشاعةً بين الجمهور، فالغموض الذي توحيه قصائدهم تتطلب من المتلقي استعدادًا خاصاً - إذا لم نصفه بالتنطُّع - لإدراك معانيها، في حين يرى الجواهري أنَّ الشعر (وجهٌ طليقٌ لا يليق به النقابُ)، وكذلك الشاعرَ إنما يراه شاعراً بمقدار تأثيره في الجمهور، وقد تعرَّض في قصيدة (أزح عن صدرك الزَبدا) إلى دعاة هذا الضرب من الشعر، مستهجناً نظرتهم إلى الشعر، منتهياً إلى تقييم نمطهم الجديد، بقوله:
وآخر يشتِمُ الجمهورَ لفَّ عليك واحتشدا
..يَعُدُّ الشعرَ أعذبَه إذا لم يجتذبْ أحدا
وشعرٍ خيرِ ما وَصَفُوا لحرانٍ إذا ابتردا
..كطعمِ الماء، تسمعُهُ كأنَّكَ تقضِمُ الْجَمدا
مـوقـفه من الديـن
على الرغم من كون الجواهري نشأ في بيئة دينية محافظة، إلا أنَّه لم يكن مثلما أُريدَ له أن يكون من لدن والده، وهو أن يعيد أمجاد أسرة آل الجواهري الفقهية، فقد تمكَّن الشعر منه إلى الحدِّ الذي جعل والده ينصاع لرغبته الأدبية، وذلك بابتياعه مجموعة من دواوين الشعر وإهدائها إليه، ولما كان شاعرنا يعيش في هذا الوسط الديني مُلاحظًا الثراء المالي عند بعض الأسر الدينية، والإدقاع الذي تُعانيه عائلته، فضلاً عن آخرين شاهدهم وهم دون مستوى الفقر، أخذ نقده لهذه الظاهرة ينمو شيئًا فشيئًا، ويزداد بتراكم التجارب والمشاهدات التي يمرُ بها، ومع نضوج تجربته الشعرية تنامى فهمه للدين بقوله: ((إن الفكرة الدينية التي نشأت عليها وجدتها في عقلي نقية صالحة)، فهي محصنة عنده ولا يمكن خرق هذه الفكرة من لدن المدَّعين، وهذا ما أدى إلى أن يعجبَ بثلة من رجال الدين في عصره ممن تحمَّل (مسؤولية رفع الظلم عن المظلومين فدخلوا، أو قادوا ثورات سياسية ضد السلطة الظالمة، أجنبيةً كانت أم محليَّة)، مثل المرجع (محمد كاظم الخراساني)، وكما يحبُّ أن يلقبه بـ(زعيم حركة التحرير الفكرية)، والميرزا (محمد تقي الشيرازي ت1338هـ)، و(شيخ الشريعة الأصفهاني ت1339هـ)، و(النائيني ت1355هـ)، والسيد (محمد سعيد الحبوبي)، والشيخ (مهدي الخالصي ت1343هـ)، والشيخ (جعفر البديري ت1369هـ)، و(أبو الحسن الأصفهاني ت1365هـ)، فالوظيفة الإصلاحية، أو الثوريَّة التي تضطلع بها الشخصية الدينية، هي المعيار في قبولها، أو رفضها عند الجواهري، ولهذا كان الدور الإصلاحي العظيم الذي قام به نبي الإسلام (محمد) (صلى الله عليه وآله) مثار إعجاب الشاعر، وهذا ما أشار إليه، بقوله من قصيدة (يا بنت رسطاليس):
ومحمداً ما إنْ أهابَ بجيشهِ يطأ البلادَ روابياً وفدافدا
ويكُبُّ جباراً، ويُعلي مُدقعاً ويُنيرُ خابطةً، ويُنهضُ راقدا
لو لم يعبِّئ للقيادةِ ثائِراً حَنِقاً على نُظُمٍ بَلينَ وحاردا
ما إنْ يروحُ مع الضعيف مُطاوعاً من لا يروحُ على القويِّ معاندا
ومن الطبيعي بعد ذلك أن يمجِّد الدور الثوري، والإصلاحي الذي قام به أئمة المسلمين الأوائل من ذرية الرسول، ولاسيما الإمام الحسين، فقد مجَّدهُ بشعرٍ لم يكن مثل كثيرٍ من القصائد التقليديَّة التي دأبت على استعراض الواقعة، ومن ثمَّ النوح واستدرار الدمع على المرثي، وإنما كان يصُبُّ في مضمونه ((باتجاه دنيوي، للإصلاح وإحياء الضمائر الميتة ورفع المظالم من المجتمع،...كما أنَّه ليس فيه اتجاه إلى البكاء والتفجع، إلا ما يأتي عرضًا)، مع الإلتفات أنَّه قال مثل هذه القصائد بعد خلعه اللباسَ الدينيَّ، أي في أربعينات القرن العشرين، وكذلك قادة المسلمين الذين انطلقوا بجيوش الفتوحات إلى سائر بقاع المعمورة، أو من قام بالتصدي للغزاة الطامعين بالبلاد العربية الإسلامية, وحملة مشعل التنوير الفكري، مثل (جمال الدين الأفغاني) (ت1314هـ)، مُترجمًا في كلِّ ما قاله بحقهم
– شعرًا أو نثرًا- إعجابه بالمواقف الوطنية والإنسانية والإصلاحية التي نُسبت لهم، فكانت باعثًا على الإشادة بهم سواءً أكان مدحًا، أم رثاءً لهم، ومميِّزًا لهم عن سواهم، ممَّن حُسِبَ على الدين، وفي واقع الأمر أنَّ حالهم لا يفترق عن حال التجار، وهذا ما صرَّح به في استذكار ثُلَّةٍ ممَّن أشرنا إلى أسمائهم آنفًا، بقوله: (إني لمدينٌ في تصوُّراتي اللاحقة عن البطولة لهذه الشخصيَّات التي جمعت قيم السماء والأرض، ولم يشغلها البحث العلمي والدين عن هموم الناس اليوميَّة...ولكن إلى جانب هذه النماذج الساطعة شهدتُ - مع الأسف- انحسار الدور الريادي للعوائل الدينية...[و] اكتفى الأبناء بالمجد الذي حققه الآباء، واتَّكأوا على عصي الوراثة وألقابها).
ومن المشاهد التي أعجب بها عند بعض رجال الدين، ما رصده بنفسه من تواضع المرجع الديني آنذاك (أبي الحسن الأصفهاني) أن رآه واقفًا أمام حانوت الخبَّاز منتظراً لوقت طويل، حتى يصل الدور إليه من الصف الذي يقف أمامه ليتناول رغيفين من الخبز، ويستهجنُ النقيض من تلك الصورة، إذ يستنكر على أحدهم أن يأتيه خادمُهُ بجوربيه على صُحفة!.
أما على صعيد التجربة الإبداعية للشاعر، فقد كانت أولى إرهاصاته الناقدة للمشهد الديني في مدينة النجف، هو ما أشار إليه تلميحاً في آخر بيتين من قصيدة (درس الشباب، أو بلدتي والانقلاب):
إنَّ في إيقاظِ قومٍ رَقَدوا خيرَ الثوابِ
وبِعِتق الناسِ من أوهامِهِمْ عِتقُ الرِقابِ
ولا يخفى أنَّ فحوى هذين البيتين تنطلق من مرتكزات دينية، لأنه لم يزل بعد لابساً زِيَّهُ الدينيَّ آنذاك، وعلى الرغم من ذلك فالنقد بيِّنُ النبرة عليهما، وقد أحسن فيهما توظيف الحجج التي يستعملها رجال الدين ضد خصومهم، وهذا ما يعني احترازاً من ردة فعلهم عليه، وحانت له فيما بعد ذريعةٌ أخرى يصب من خلالها نقده لهؤلاء، وذلك باختياره ترجمة نصوص شعرية للشاعر الإيراني (حافظ الشيرازي)، وتعرب -بحسب رؤية الدكتور الأعرجي- عن روحٍ تغلي بتحدي المجتمع والسلطة الدينية، فضلاً عن كونه يريد أن يعرف مدى ردة فعل رجال الدين من وجهٍ لا يستطيعون أن يؤاخذوه عليه؛ إذ أعلن في تقديمه لترجمة هذه الأبيات أنه: (ليس لي من غرض خاص يحملني على نشرها سوى الخدمة الأدبية اللغوية، وفيما أنشره في الضمن من الآراء المقررة والقوانين العامة المتفق عليها ما يبرر ذلك، وكل ما يأتي من ذلك القبيل فهو واسطة لا غاية، والأعمال بالنيات).
اكثر قراءة